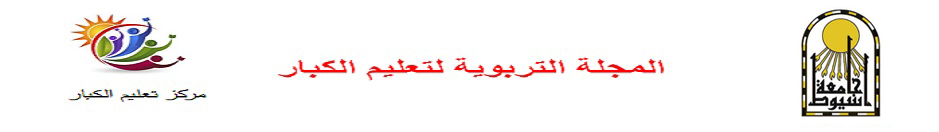
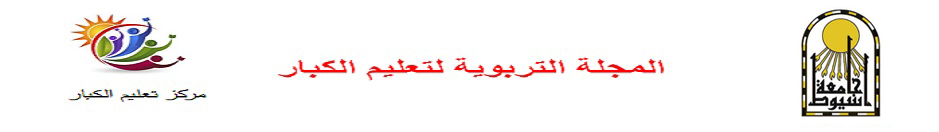
نوع المستند : أوراق بحثیة
المؤلفون
1 اسيوط - البداري - منشاة العقال البحري
2 کلية التربية جامعة أسيوط
3 كلية التربية-جامعة أسيوط
المستخلص
الكلمات الرئيسية
الموضوعات الرئيسية
كلية التربية
كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
المجلة التربوية لتعليم الكبار– كلية التربية – جامعة أسيوط
=======
متطلبات تطبيق الادارة الموقفية في التعليم الأزهري
قبل الجامعي
بحث للتسجيل لدرجة الماجستير في التربية
( تخصص تربية مقارنة وإدارة تعليمية )
إشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراف
الأستاذ الدكتور الدكتورة
أحمد عبد الله الصغير البنا إیمان عبد الوهاب هاشم
أستاذ ورئيس قسم أصول التربية مدرس أصول التربية
كلية التربية - جامعة اسيوط كلية التربية - جامعة أسيوط
إعداد الباحث
عماد الدين على محمد احمد
معلم لغة انجليزية بالمعهد الاعدادي الازهري
بإدارة البدارى التعليمية الازهرية - محافظة أسيوط
} المجلد السادس – العدد الرابع – أكتوبر 2024م {
مستخلص البحث:
هدف البحث الى تعرف الاطار الفكري للإدارة الموقفية ، وماهية التعليم الأزهري قبل الجامعي ، ووضع تصور مقترح لأهم متطلبات تطبيق الادارة الموقفية في التعليم الأزهري قبل الجامعي ، واستخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي .
وقد توصل البحث الى مجموعة من المقترحات التي تمثل اهم متطلبات تطبيق الادارة الموقفية في التعليم الأزهري قبل الجامعي وتتمثل في :
متطلبات خاصة بالأهداف، متطلبات خاصة بالتخطيط، متطلبات خاصة بالتنفيذ، متطلبات خاصة بالإدارة.
الكلمات المفتاحية :
متطلبات – الإدارة الموقفية _ في التعليم الأزهري قبل الجامعي
Research abstract:
The research aimed to identify the intellectual framework of situational management, the nature of pre-university Al-Azhar education, and to develop a proposed vision for the most important requirements for applying situational management in pre-university Al-Azhar education. The research used the descriptive analytical method.
The research reached a set of proposals that represent the most important requirements for applying situational management in pre-university Al-Azhar education, which are:
Requirements specific to objectives, requirements specific to planning, requirements specific to implementation, and requirements specific to management.
Keywords:
Requirements - Situational management - in pre-university Al-Azhar education
مقدمــة :
يعد مفهوم اللامركزية من المفاهيم الحديثة التي بدأ ظهورها في مصر وخاصة مع ما يعانيه نظام التعليم من تحديات ذات طبيعة مؤسسية وثقافية دعت إلى تبنى المفهوم فكراً وممارسة حيث يتنبأ تطبيق هذا الأسلوب داخل النظام التعليمي الأزهري لتحقيق أكبر قدر من المرونة في إصدار القرار وتنفيذه في تشخيص المشكلات وابتكار الحلول بالإضافة إلى كونه مدخلاً ورؤية للإصلاح المؤسسي التعليمي ورف مستوى جودة أداء مجمل المؤسسة التعليمية الأزهرية بصفة عامة وجودة المنهج الأزهري بصفة خاصة .
ونقل السلطة من القيادات المركزية إلى القيادات والمجتمعات المحلية والمدارس ومشاركة أولياء الأمور يمكن أن يؤدي لتحسين تقديم الخدمات التعليمية ومن ثم تطوير وتحسين التعليم، وعلي الرغم من الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم في مصر والإنجازات التي تحققت في مجال التعليم قبل الجامعي لتطويره وتحديثه إلا أن منظومة التعليم الأزهري مازالت تعاني من بعض أوجه القصور وتحتاج لقدر كبي من التطوير والتحديث وصولاً للآفاق المرجوة والتنمية والكفاءة حتي يحقق التعليم الأزهري أهدافه الأساسية التي تتفق مع روح العصر ولهذا نحتاج إلي أن نتجه في التعليم الأزهري نحو تطبيق اللامركزية كأسلوب وصيغة للإصلاح والتطوير خاصة في مجال التعليم .
ومفهوم المركزية او اللامركزية يرتبط اساسا بتفويض السلطة، ويعكس مفهوم المركزية تركيز السلطة، بينما يعبر مفهوم اللامركزية عن تشتيت السلطة وتوزيعها، وعملية التركيز او التشتيت للسلطة لا تتعلق بنوع السلطة، انما يتعلق بكمية السلطة، فاللامركزية في السلطة مظهر من مظاهر التفويض ، فالسلطة اذا لم تفوض فهي مركزية واذا فوضت فهي لامركزية ([1]).
ومن الناحية العملية لا توجد مركزية أو لامركزية مطلقة، بل هناك موائمة بيت ما تحققه المركزية من الرقابة الفعالة على الاجهزة التعليمية المحلية، وما تحققه اللامركزية من سهولة انطلاق العمل، بينما من الناحية النظرية التربوية فان الدولة التي تؤمن بتوحيد النظم التعليمية تتبع المركزية، أما الدولة التي تؤمن بالتعدد والتنوع والفروق الفردية بين الأفراد والاختلاف في الظروف الطبيعية والجغرافية والعوامل المجتمعية في البيئة المحلية فتتبع اللامركزية ([2]).
وتعتمد معظم الدول التي تتبع نمط اللامركزية في الإدارة التعليمية على تحقيق نوع من التوازن بين السلطات المركزية والمحليات والمستوى الإجرائي وهو توازن نسبى يختلف من دولة الى اخرى فهناك دول يزيد فيها دور السلطات المركزية، وتقل فيها سلطات المستويات الأدنى والعكس، فالموقف الحالي للإدارة التعليمية يقوم على اساس المشاكلة بين المركزية واللامركزية. ([3])
وتركز اللامركزية السياسية على تطبيق أكبر قدر من الديمقراطية على المستويات المحلية، وضمان المشاركة المجتمعية لاتخاذ القرار، بينما تركز اللامركزية الإدارية على تحويل السلطات والمسؤوليات الادارية الى المستويات الادارية الادنى في تعيين الموارد المالية وكيفية انفاقها، ومن ثم فأنها متضمنة كل من اللامركزية السياسية الادارية ([4]) .
ويتضح مما سبق أهمية تطبيق النمط اللامركزي في الإدارة التعليمية، وهذا ما ستحاول
الدراسة فعله.
مشكلة البحث:
لاحظ الباحث من خلال خبرته في مجال التدريس بالأزهر الشريف تأثر العاملين بالمركزية وما لها من تأثيرات إيجابية وسلبية - وإن كانت التأثيرات السلبية -أشد على الأداء الوظيفي، حيث ان الازهر يتبع نظام المركزية في الإدارة، وهذا النظام له مشكلات عديدة تتمثل في :
الروتين والبيروقراطية الإدارية والبطء في اتخاذ القرار، والحد من الإبداع والابتكار في العملية التعليمية، وعدم تفويض السلطات الإدارية، والازدواجية في تنفيذ المهام، وغيرها .
وهذه المشكلات يمكن مواجهتها من خلال تطبيق النمط اللامركزي في الإدارة والذى يتميز بالتخلص من الإدارة البيروقراطية، إضافة إلي السعي الدائم لخلق التنافس بين المدارس في مجال التحصيل، وخلق مناخ تعليمي ديموقراطي من اجل تطوير النظام التعليمي، وبناء الشخصية التربوية المستقلة، والعمل الجاد نحو الكفاءة الوظيفية للموارد وتحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة، هذا كله إلي جانب زيادة الكفاءة الإنتاجية والتوزيعية والفنية، وأيضا لصعوبة الاتصال احيانا بين المدرسة والإدارة التعليمية والحاجة الماسة لتفعيل دور مجلس الامناء والاباء والمعلمين وإبراز دور المجتمع والتفاعل المستمر مع البيئة الخارجية كان من أهم المبررات لتفعيل دور الإدارة اللامركزية في التعليم الاساسي، والذي يعمل علي إزالة كل العقبات وتسهيل عمليتي التعليم والتعلم ([5]) .
كما أشارت حصيلة المناقشات التي تعتلى هامش مؤتمر الإصلاح المؤسسي للتعليم يعتمد علي الأساليب العصرية في الإدارة وعلي استراتيجية شاملة لتطبيق اللامركزية مع الاهتمام بدعم أجهزة المحليات التي يمكن من خلالها تحقيق الديمقراطية والمشاركة في صنع القرار. واعتماد الاصلاح المؤسسي للتعليم في المدرسة علي الاستقلال الذاتي علي جهود مدير المدرسة ومعاونيه علي ان يكون مدير المدرسة هو القائد الفعلي الذي يعتمد عليه النهوض بالعملية التعليمية في مدرسته وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لتحقيق أهداف التعليم ([6]).
أهمية البحث :
تنقسم أهمية الدراسة الى:-
(أ) أهمية نظرية:
تتمثل أهمية الدراسة النظرية فيما تقدمه من بعض المعلومات والمعارف عن التعليم الأزهري ما قبل الجامعي، وماهية الإدارة الموقفية في التعليم، والواقع الحالي لتطبيق النمط المركزي في إدارة التعليم الأزهري ما قبل الجامعي، ومشكلاته.
دراسات سابقة :
هناك بعض الدراسات والبحوث العربية والأجنبية تناولت بعض جوانب الإدارة التعليمية والأنماط المتعلقة باللامركزية في الإدارة التعليمية، وهناك بعض الجوانب المشتركة بين هذه الدراسات والبحوث والدراسات الحالية، وتعرضها الدراسة مرتبة ترتيبا زمنيا من الأحدث الى الاقدم.
اولا : الدراسات العربية :
1- دراسة زينب احمد محمد سليمان (2016): ([7])
هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم اللامركزية في التعليم الأساسي، والتعرف على الواقع الحالي لإدارة مدارس التعليم الأساسي، والمشكلات التي تواجه محاولات التوجه نحو اللامركزية، ووضع استراتيجية مقترحة لتفعيل اللامركزية في إدارة التعليم الأساسي في ضوء خبرات بعض الدول، واستخدمت الباحثة المنهج المقارن لمناسبته لطبيعة الدراسة ، كما استخدمت الاستبانة كاداه رئيسة للدراسة الميدانية، وبلغة العينة ككل (1302) فردا منه(398) مديرا ، و (904) معلما ، وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج من أهمها ما يلي:
إجماع أفراد العينة الكلية على تحقق لامركزية إدارة التعليم الأساسي بدرجة متوسطة وبوزن نسبى (67) مما يشير الى ضرورة تفعيل اللامركزية بإدارة التعليم الأساسي بمحافظة اسيوط – جاء محور "توافر المعلومات " في المرتبة الأولى من منظور العينة ككل بدرجة متوسطة وبوزن نسبى (69). مما يؤكد على حاجة الإدارات بمدارس التعليم الأساسي بمحافظة اسيوط إلى مزيد من المعلومات والبيانات المطلوبة - جاء محور التنمية المهنية في المرتبة الأولى برجة متوسطة في منظور العينة ككل أيضا وبوزن نسبى (69)، مما يدل على الحاجة إلى مزيد من برامج التنمية المهنية بمدارس التعليم الأساسي الداعمة للامركزية إدارة التعليم الأساسي - جاء محور تفويض السلطة في المرتبة الثالثة بدرجة متوسطة من منظور العينة ككل أيضا بوزن نسبى ،(68.) ، مما يشير إلى حاجة مديري المدارس لتفويض السلطة في تطبيق لامركزية إدارة التعليم الأساسي. واصى البحث عدة توصيات منها:-
1- ترسيخ ثقافة اللامركزية والإدارة الذاتية في مدارس التعليم الأساسي وجعلها جزء لا يتجزأ من الثقافة العامة لهذه المدارس.
2- ضرورة توفير الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لتطبيق اللامركزية.
2 دراسة محمد ابراهيم محمد ابوخليل (2011): ([8])
هدفت هذه الدراسة الى تحليل النصوص النظرية المنظمة في نصوص دستورية وقانونية ولوائح وقرارات وزاريه تدعو إلى تطبيق اللامركزية، وتحليل مظاهر الفجوة بين النظرية والتطبيق، والوقوف على أراء بعض قيادات التعليم حول الاليات المقترحة لتحقيق اللامركزية، واتجاهاتهم حاليا، ووضع مجموعه من السبل والإجراءات لتفعيل التطبيق الفعلي لتلك الآليات.
واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي.
وتم تصميم استبيان لمعرفة بعض آليات تحقيق اللامركزية والاتجاهات نحوها.
وتوصلت الدراسة الى عدت نتائج منها :
(3) دراسة امال سيد محمد مسعود ( 2010 ) : ([9])
هدفت هذه الدراسة إلي تمكين المدارس الثانوية ومجتمعها المحلى من ممارسة الإدارة المتمركزة على المدرسة وتحقيق الاستقلال الذاتي لها.
واستخدمت الدراسة المنهج الالفينومينولوجي حيث سيتم معالجة مشكلات الربط بين التحليلات السيكولوجية التربوية لواقع متطلبات تحقيق الاستقلال الذاتي للمدرسة الثانوية في ضوء لامركزية التعليم.
وتوصلت الدراسة إلي عدة نتائج من أهمها:-
4- دراسة عبد الحميد عبد الفتاح عبد الحميد (2007): ([10])
منهج البحث وإجراءاته : اعتمد البحث الحالي على المزاوجة بين المنهج الوصفي وأسلوب تحليل النظم ، وفي ضوء المنهج المستخدم والأدوات المساعدة له جاءت الإجراءات على النحو التالي:-
إطار نظري يتمثل في طبيعة عملية صنع القرار المدرسي وخصائصها واساليبها، والعوامل المؤثرة فيها، والمقومات الأساسية لجودتها، وكذلك طبيعة اللامركزية وأنماطها ومبررات الأخذ بها ومعوقات ومتطلبات تطبيقها، وأثرها على فاعلية صنع القرار المدرسي - نماذج دولية في مجال تطبيق لامركزية التعليم، وأهم الدروس المستفادة منها، الدراسة الميدانية والتي تضمنت الاداة والعينة وتحليل النتائج، وهذا ما يتضح فيما بعد بناء تصور مقترح لتفعيل جودة عملية صنع القرار المدرسي.
5- دراسة ايمن محمد البيومي (2006): ([11])
هدفت الدراسة إلى تقويم مشروع إصلاح التعليم بالإسكندرية في ضوء فلسفة وأهداف نماذج الإصلاح الشامل للمدارس.
منهج الدراسة وأدواتها استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، والاستبانة، والمقابلة.
أهم النتائج اللامركزية: هناك عدة مظاهر تدل على فشل اللامركزية مثل عدم قدرة المدارس علي التصرف في ميزانيتها دون الرجوع الى الإدارة التعليمية، إعاقة المتابعين في جهود الإصلاح من خلال توجهاتهم المتعارضة والتي تكشف عن عدم تخصصهم في التربية واقتصارهم على مهارات المتابعة، مما أصاب عمل المعلمين بالارتباك والجمود خوفا من التعرض للجزاءات، عدم تطبيق اليات اللامركزية مثل المحاسبية والشفافية
وجود سيادة مركزية، وغياب المشاركة المجتمعية في المنظومة التعليمية، وكذلك غياب قواعد ذلك البيانات الدقيقة علي كافة المستويات، ومع يوجد مبادرات فردية تتم علي مستوى بعض المدارس.
6 - دراسة ناصر محمد عامر (2006): ([12])
سعت هذه الدراسة إلى تحقيق أهداف منها التعريف بثقافة اللامركزية في التعليم، والوقوف على خبرات بعض الدول الاجنبية في التوجه نحو اللامركزية التعليم، وبيان أوجه التشابه والاختلاف بين الدول المختارة لاستخلاص منطلقات أساسية تكون بمثابة موجهات للتحول نحو لامركزية التعليم ورصد الجهود المصرية الراهنة في التوجه نحو لامركزية التعليم.
7- دراسة احمد نجم الدين احمد عيدا روس (2005): ([13])
استهدفت الدراسة التعرف على طبيعة إدارة عملية التخطيط الاستراتيجي من حيث مفهومها وخطواتها ومبرراتها في الأدبيات، مفهوم الإدارة المرتكزة إلى المدرسة وسماتها في الفكر الإداري المعاصر، والوضع الراهن لإدارة المؤسسات التعليمية للتعليم العام بمصر.
منهج الدراسة : استخدمت الدراسة المنهج الوصفي.
اهم النتائج توصلت الدراسة إلي نتائج توضح معوقات الإدارة المدرسية وتهدد فاعليتها على الانجاز وتحقق الأهداف في ضوء بيئتها الداخلية والخارجية منها ندرة وجود مناخ صحي يوفر الثقة والمصداقية بين القادة والمرؤوسين والشعور بالانتماء، وندرة الاخذ بالمدخل المتكامل للإدارة الاستراتيجية الأخذ بالمركزية طبقا للهيكل التنظيمي القائم، وضعف عملية الرقابة التقليدية ومعايير الأداء وحوافزها، ومن خلال هذه النتائج أصابت الدراسة التصور المقترح لتطبيق بنيوية الفدرالي الادارية بمؤسسات التعليم العام، وتمثلت عناصره في مشكلات الواقع، وتوقعات مستقبل المرتكزات والاجراءات المقترحة على المدى القريب والبعيد.
8_دراسة خميس فهيم عبد الفتاح عبدالعزيز (2005): ([14])
هدفت تلك الدراسة للتعرف على الاسس التي تستند اليها الإدارة الذاتية للمدرسة في الفكر الإداري المعاصر، وتحديد مبررات تطبيق الإدارة الذاتية للمدرسة الثانوية العامة بمصر، ومن ثم وضع مجموعة من السبل والاجراءات لمحاولة تطبيق الإدارة الذاتية في المدارس الثانوية العامة بمصر في ضوء الافادة من معطيات الفكر الإداري المعاصر واراء متخصصي الادارة التربوية.
واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي.
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من المتطلبات اللازمة لتطبيق الإدارة الذاتية في المدارس الثانوية العامة بمصر والتي منها:-
1_الاجراءات اللازمة لتطبيق لامركزية الإدارة ومنها :
الأخذ بمقترحات المعلمين عند تطوير المناهج في المستويات الأعلى. ومشاركة مجلس إدارة المدرسة في جهود تطوير العملية التعليمية داخلها والمرونة في تطبيق التشريعات المنظمة للعمل المدرسي.
وتفويض مجلس إدارة المدرسة في اتخاذ القرارات التي تؤدى إلى تحسين أدائها. ومنح مجلس إدارة المدرسة السلطات الازمة لإعداد ميزانيتها الثانوية .
تحول التنظيم الإداري من التنظيم الهرمى إلى تنظيم يقوم على المشاركة وتدريب العاملين بالمدرسة على المهارات اللازمة للمشاركة في صنع القرار .
3_ الإجراءات اللازمة لتحقيق التنمية المهنية المستدامة ومنها :
تدريب افراد الجهاز الإداري بالمدرسة على مهارات استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارتها.
وشمول برامج التنمية لكل الكوادر العاملة بالمدرسة وتفعيل التعاون بين المدرسة ومراكز التدريب عن بعد في تنفيذ برامج التمية المهنية.
4- الإجراءات اللازمة لنشر المعلومات المرتبطة بالمدرسة ومنها إعداد المدرسة سجلات لمتابعة أداء طلابها بصفة مستمرة، وقيام كل مدرسة بإنشاء قواعد بيانات خاصة بها باستخدام الحاسب الآلي وقيام المدرسة بإجراء دراسات مسحية لمعرفة مدى رضا أفراد المجتمع عن أدائها.
5- الإجراءات اللازمة لتطبيق المحاسبية التعليمية ومنها :
ان يكون الترقي على اساس الكفاءة وليس الاقدمية فقط ، والاتفاق على مواصفات الاداء الجيد للعاملين بالمدرسة.
9- ودراسة رشيد خالد منصور (2004): ([15])
هدفت تلك الدراسة للتعرف على المستويات الإدارية المرغوب فيها لاتخاذ القرارات المتعلقة ببعض المهام التربوية وهي:
المناهج الدراسية، وطرق وأساليب التدريس ، وشئون الموظفين، والشؤن الطلابية، والمرافق المدرسية، والشئون المالية من وجهة نظر مديري ومديرات المدارس الحكومية التابعة لمديريات التربية والتعليم في شمال الضفة الغربية الفلسطينية وتحديد. اثر متغيرات الدراسة المتمثلة في:
المؤهل التربوي وسنوات الخبرة الإدارية والجنس، ومستوى المدرسة والمدرية على المستويات الإدارية المرغوب فيها لاتخاذ القرارات المتعلقة بتلك المهام التربوية.
واستخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي والاحصاء الوصفي. ومن أهم النتائج التي أسفرت عنها الدراسة ما يلي:-
الشؤون المالية والمرافق الدراسية، وطرق واساليب التدريس، والشؤون الطلابية، كتوجيه لنمط الإدارة المركزية، بينما اختاروا مستوى الوزارة بما يتعلق بالمناهج ويعتبر ذلك توجه لامركزي.
توجد فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغيرات المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والجنس، ومستوى المدرسة، ومستوى المدرية، ولا توجد فروق ذات دلالة إحصائية لمتغير المؤهل التربوية بين المستويات المرغوب في اتخاذ القرارات المتعلقة ببعض المهام التربوية، وأوصت الدراسة بضرورة استمرار وزارة التربية والتعليم في دعم التوجه نحو اللامركزية في الإدارة التربوية في فلسطين.
10 - دراسة نبيل سعد خليل (2003): ([16])
هدفت تلك الدراسة إلى دراسة الإدارة التعليمية في كل من فرنسا والولايات المتحدة الامريكية، بهدف تحسين نظام الإدارة التعليمية في مصر، من خلال الفهم الدقيق لمشكلاتنا والتصدي لها، ومحاولة وضع حلول لها، وتحليل عناصر السلطة التعليمية ودراسة دورها في التخطيط واتخاذ القرارات والتنفيذ.
ووضع تصور لما يمكن ان تكون عليه طبيعية العلاقة بين سلطات الإدارة التعليمية القومية والمحلية في مصر في ضوء الواقع الجديد للمجتمع المصري.
واستخدمت الدراسة المنهج المقارن.
وتوصلت الدراسة الى عدت نتائج من أهمها:-
إعادة النظر في اختصاصات الاجهزة المركزية، ونقل بعضها إلى السلطات المحلية، من أجل توزيع السلطات والاختصاصات بشكل أوسع ، ومنح كل مؤسسة تربوية سلطات تجيز لها تكييف نظامها التربوي ليتلاءم مع متطلبات ظروفها الخاصة واتخاذ المبادرة من جانب هذه السلطات.
ان يحدد لكل مدرية ميزانية مستقلة بحيث لا تلجا للوزارة في أي شيء، بهدف اعطائها الاستقلال المالي والإداري بحيث تكون مسؤولة عن المناهج واختيار الكتب وشؤون العاملين.
ترك الحرية للجهود الذاتية في الإنشاء والمباني المدرسية، ودعم ذلك من ميزانيات المجالس الشعبية، واعطاء تلك المجالس حق فرض الضرائب لصالح التعليم.
ان يتوافر للمعلمين حرية العمل، وان يتمتعوا بسلطة واسعة في تكييف محتوى المناهج.
ثانيا : الدراسات الاجنبية :
1- دراسة بيجورك(Bjork 2003 ) : ([17])
جاءت تلك الدراسة تحت عنوان "سياسة اللامركزية التعليمية في إندونيسيا "، وهدفت تلك الدراسة إلى توضيح ردود فعل المديرين والمدرسين تجاه تطبيق سياسة اللامركزية التعليمية في إندونيسيا, فأوضحت ان هناك تأثيرا كبيرا للسلطات والحكومات المركزية على آرائهم واتجاهاتهم نحو تطبيق اللامركزية، اذ انه توصل الى قلة وجود أي تأثير للوقت على تطبيق اللامركزية التعليمية ولكنه ارجع الصعوبات التي تواجه المديرين في تطبيق اللامركزية على ذلك.
2_دراسة باريرا او سیوریوAdolfo Merino Juarez Gustavo 2002)) : ([18])
جاءت هذه الدراسة بعنوان "اللامركزية" والتعليم في كولومبيا : "دراسة" إبريقيه"، وهدفت تلك الدراسة التعرف علي تحليل الآراء حول اللامركزية والتعليم في كولومبيا، والعلاقة بين اللامركزية وجودة التعليم، ودراسة هدة العلاقات بين التلاميذ ذوى الدخول المختلفة، واستخدمت الدراسة المنهج شبة التجريبي لتحليل العلاقة بين تطبيق اللامركزية وجودة التعليم في كولومبيا، وأشارت الدراسة إلي ان اللامركزية - من الناحية النظرية - ربما تزيد من كفاءة النظام في توفير الخدمات التعليمية ومن ثم يكون من المتوقع ازدياد تحسین جودة التعليم في هذه المدارس التي تطبق فيها اللامركزية، كما يمكن للامركزية خلق توزيع غير متساوي لجودة التعليم ومن ثم فإنه من المتوقع ان يكون تأثيرها غير متماثل مع الدخل، وجاءت نتائج الدراسة متضاربة، فقد وجد أثر إيجابي لتطبيق اللامركزية.
التعليق علي الدراسات السابقة:
قدمت فيما سبق مجموعة من الدراسات السابقة العربية والأجنبية والتي استفدت منها في دراستي الحالية، ومن هذه الدراسات ما تشابه في جزئية مع الدراسة الحالية وما اختلف عنها، وقد عرضت الدراسات السابقة بناء علي ترتيبها الزمني - سواء اكانت العربية او الاجنبية من الأحدث الى الاقدم:
وعرضت كل دراسة بمعرفة موضوعها وأهدافها والمنهج المستخدم لتنفيذها وأداتها وأهم النتائج التي أسفرت عنها ، وأهم التوصيات التي أكدت عليها ، ويمكن الخروج منها بما يلي:-
1- ركزت الدراسات السابقة علي محاور عدة تتمثل فيما يلي:-
تناولت بعض الدراسات السابقة تطوير الإدارة التعليمية والمدرسية وتنظيمها، والمشكلات التي تواجههم وعرضت بعض الدراسات لامركزية الإدارة التعليمية من حيث المميزات والعيوب واهميتها في إدارة وتطوير التعليم وزيادة جودته، ومعوقاتها وطرق تطوير مهارات اتخاذ القرار لتفويض السلطة. مثل دراسة نبيل سعد خليل (2003).
وأوضحت بعض الدراسات أهمية المشاركة الاجتماعية في العملية التعليمية والإدارة التعليمية، وأثر العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية علي الإدارة التعليمية واظهرت بعض الدراسات واقع الإدارة التعليمية في مصر وطبيعة العلاقة بين السلطات التعليمية القومية والمحلية، وعناصرها وأدوارها في التخطيط واتخاذ القرار والتنفيذ مثل دراسة نبيل سعد خليل (2003)، واستفدت كباحث من هذه الدراسات في التعرف علي واقع الإدارة التعليمية في مصر وعناصر السلطة التعليمية في مصر وادوارها في التخطيط والتنفيذ واتخاذ القرار مثل دراسة ادولف Adolf (2000) ودراسة - احمد نجم الدين احمد عبدا روس (2005) ودراسة ايمن محمد البيومي (2006) ودراسة محمد ابراهيم محمد ابوخليل ،(2011) ، ودراسة ناصر محمد عامر (2006) ، ودراسة امال سید محمد مسعود (2010)، ودراسة خالد قدري ابراهيم (1999)، ودراسة نبيل سعد خليل (2003).
وتناولت بعض الدراسات الفكر الإداري الجديد في بناء الاستراتيجية المقترحة للامركزية التعليم في مصر والاتجاهات المعاصرة في الإدارة، وأهمية الاستفادة منها في تطوير الإدارة التعليمية.
ركزت بعض الدراسات السابقة في تناولها علي المعايير القومية للتعليم والمدرسة الفعالة. مثل دراسة عادل عبد الفتاح سلامة ،(2000)م.
ركزت بعض الدراسات السابقة في تناولها علي التخطيط الاستراتيجي مثل دراسة احمد نجم الدين عيدا روس (2005).
وتناولت بعض الدراسات السابقة أهمية الارتقاء بأدوار النظار والمديرين في المدارس، وأهمية ادوارهم ومعايير الإصلاح لتحقيق جودة العملية التعليمية.
مما سبق يتضح أن الدراسات السابقة قد قدمت إسهاما كبيرا ساعد علي تحديد الإطار النظري للدراسة الحالية كما انها قدمت بعض المؤشرات إلي يمكن الاستفادة منها.
2 - موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:
من خلال عرض الدراسات السابقة يمكن استخلاص موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة وهى ان الدراسة الحالية تركز على وضع تصور مقترح لتفعيل الادارة الموقفية في التعليم الأزهري ما قبل الجامعي بمعاهد محافظة اسيوط، بينما تركز الدراسات السابقة على تناول متغيرات مختلفة تم ذكرها آنفا.
3- اوجه الاستفادة من الدراسات السابقة:
استفاد الباحث من الدراسات السابقة بما يلى:
1_مساعدة الباحث في بلورة مشكلة الدراسة.
2-مساعدة الباحث في اختيار المنهج المناسب للدراسة والمتمثل في المنهج الوصفي.
3_مساعدة الباحث في تقييم أدوات الدراسة.
4_تزويد الباحث بالمعلومات والمعارف لعرض الإطار النظري للدراسة وفى تفسير نتائج الإطار الميداني.
أسئلة البحث :
تحاول الدراسة الإجابة عن التساؤلات الأتية:
1_ما الإطار الفكري والفلسفي للإدارة الموقفية في إدارة التعليم؟
2_ماهية التعليم الأزهري ما قبل الجامعي من حيث مفهومة، فلسفته، وأهدافه، ومناهجه، وأدواته، ومشكلاته؟
3_ما الواقع الحالي لنمط الإدارة المركزية في التعليم الأزهري ما قبل الجامعي وما مشكلاته؟
4_ما متطلبات تطبيق الإدارة الموقفية في التعليم الأزهري ما قبل الجامعي؟
5_ما التصور المقترح لتطبيق الإدارة الموقفية في التعليم الأزهري ما قبل الجامعي؟
منهج البحث :
المنهج الوصفي: وذلك لملائمته لطبيعة الدراسة من حيث وصف وتحليل متغيرات الدراسة.
حدود البحث : سوف تقتصر الدراسة على الحدود التالية:-
حد الموضوع : وتتمثل في دراسة الإدارة الموقفية لتطبيق اللامركزية في التعليم الأزهري ما قبل الجامعي.
مصطلحات البحث:
1- الإدارة الموقفية : ويعرفها الباحث إجرائيا بانها أحد أساليب التنظيم الإداري في معاهد التعليم الأزهري ما قبل الجامعي والذى يهدف إلى توزيع السلطات، وإعطاء الحرية في اتخاذ القرارات، حيث يجري العمل به وتنفيذه علي مستوي معاهد التعليم الأزهري ما قبل الجامعي.
2- التعليم الأزهري ما قبل الجامعي : يعرفه الباحث إجرائيا بانه التعليم الأزهري قبل المرحلة الجامعية، ويتمثل في ثلاث مراحل هي ( الابتدائية الاعدادية الثانوية)، ومدة الدراسة بها اثنا عشر سنة، ويدرس الطالب من خلاله القرآن الكريم في جميع المراحل بالإضافة الى مواد شرعية وعربية وثقافية بالنسبة للمرحلتين الاعدادية والثانوية.
خطوات السير في البحث:
تم الإجابة عن تساؤلات البحث وتحقق اهدافها من خلال المحاور الاتية:
المحور الاول ما الإطار الفكري للإدارة الموقفية ؟
والإدارة الموقفية هي الإدارة التي تقر بأن النمط القيادي الذي يمكن أن يستخدمه القائد يتغير حسب الموقف، وأن هناك ظروفًا وعوامل متعددة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لاختيار نمط القيادة في كل موقف ([19]) .
أولاً : مفهوم الإدارة الموقفية :
أن كلمة الإدارة تعود في أصلها إلى الفكر السياسي والإداري الغربي (Administration) إلى الكلمة اللاتينية Administrare والتي تعني تقديم خدمة حيث تلعب الإدارة دورًا كبيرًا وعظيمًا في تقدم الأمم والمجتمعات في مختلف أرجاء العالم وتقديم مختلف الخدمات والقيام الصالح العام، حيث أصبحت الإدارة العامة وطبيعة الخدمات التي تقدمها بمثابة الترمومتر لقياس مدى تقدم وازدهار الدول والأمم ([20]).
وتعرف كلمة الإدارة في اللغة بأنها جعل الحركات تتواتر بعضها في إثر بعض، جعله يدور أدار الآلة، أدار محرك السيارة : شغله، جعله يدور ويعمل، والتشغيل يعني العمل وفق سياق متناسق ومنسجم لتقديم ،غرض منتوج أو غاية معينة ([21]) .
وتعرف اصطلاحًا بأنها : علم ليس بسيطًا في الممارسة الميدانية وإدارة المنظمات فوجهات النظر التقليدية والكلاسيكية عند فريدريك تايلور وهنري فايول تواصل المحافظة على أهميتها وتلعب دورًا مهما رغم الإسهامات الحديثة والجديدة في حقل الإدارة([22]).
ثانيًا : أهمية الإدارة الموقفية :
ترجع أهمية الإدارة الموقفية إلى الأساليب التي يتبعها القائد الإداري ومنها ما يلي:
1- تعطي الفرصة للقائد الإداري تشكيل أسلوب قيادته بما يتناسب ومستوى استعداد الفريق واحتياجاته الأمر الذي من شأنه التأثير على أداء الفريق لأن القائد يستخدم أسلوبًا يحفز الموظف ويحسن أدائه ([23]) .
2- يكون القائد الإداري قادرًا على نهج القيادة المختار بطريقة تساهم في قيادة الفريق وتطوير مستواه في نفس الوقت.
3- لديها أثر فعال في زيادة الوعي، حيث يجب أن يكون قادة الموقف على دراية بما يحدث من حولهم من خلال زيادة وعيهم.
4- يكون القائد الإداري متوافقًا أهداف المؤسسة وأن يكون مدركا تمامًا للخطوات مع التي يجب اتخاذها للوصول إلى الأهداف([24]).
ثالثًا : مهام الإدارة الموقفية (القائد الإداري) :
أن القائد الفعال هو الذى يؤدي كل الأدوار والمهام المطلوبة منه بشكل متميز في مختلف المواقف التي توجدها الظروف والمتغيرات، ومنها ما يلي : ([25])
1- صنع القرار Decision making هو ذو صلة مباشرة بسلوك القائد الإداري وعمله، إذ يعد المرآة التي تنعكس عليها أعماله ،
2 - تقييم الأداء Performance evaluation : تحتاج جميع المؤسسات لتقييم أدائها بين فترة وأخرى للوقوف على المعوقات التي تحد من عمل المؤسسة والنجاحات التي تحققها وكل ذلك يقع على عاتق المدير أو القائد الإداري
3- مواجهة الأزمة facing crises : حيث أن مواجهة القائد للضغوط الداخلية والخارجية تتطلب قدرات وقابليات كبيرة من أهمها القدرة على الصمود والشجاعة
رابعا : دور الإدارة الموقفية في معالجة المواقف والأزمات :
وأن الأزمة ظاهرة اجتماعية متعددة الجوانب ومتداخلة ويتعين دراستها في اطارها المجتمعي الذي نشأت فيه وتأثيرها عليه، فضلا عن تفاعلها مع معطياته وظروفه التي يمر بها وبالتالي فأنه لا يمكن اغفال دور المجتمع في الاستجابة او رفض او حتى تغيير خصائص واتجاهات الازمات لأنه ليس كل ما يأتي مع الازمات سلبي بل ان ادارتها وكيفية مواجهتها هي التي تحدد مدى وحجم الخسائر لكل ازمة اضافة الى ان الادارة الرشيدة للازمة يمكن ان تحول التغييرات التي تصاحب الازمات الى لصالح المنظمة من خلال الاستثمار الامثل للتغييرات وبما يخدم المنظمة([26]).
ثامنًا : أساليب الإدارة الموقفية :
إن أساليب الإدارة الموقفية تختلف عن مواصفاتها، ومن أهم أساليب الإدارة الموقفية ما يلي([27]) :
الإشراف : في هذه الحالة فإن القائد الموقفي يضع بعين الاعتبار مهارات الأفراد ومستوى جاهزيتهم لإتمام الأعمال، وبالتالي فإن القائد الموقفي يشرف على عملية إتمام المهام وإنجازها بطريقة تفوضه للتدخل إذا لزم الأمر.
التدريب : في هذه الحالة، يقوم القائد الموقفي بتدريب فريقه، حيث يقوم القائد بتقديم تعليمات مفصلة ولكنه يركز أيضًا على تحفيز المرؤوسين والبحث عن المدخلات وشرح سبب اتخاذهم لقرارات معينة.
المشاركة : تكون المشاركة من خلال منح القائد الموقفي لمرؤوسيه إمكانية اتخاذ القرارات ضمن عدد من الخيارات الروتينية، والقائد الموقفي يعطي القليل من المساحة للمرؤوسين حتى يشاركوا في عملية صنع القرار، وهو يعتبر فقط مشاركة وليس تمكين أو تفويض.
التفويض : يظهر التفويض كأسلوب قيادة موقفية عندما يكون القائد مرتبط بفريق عمل على مستوى عال من الكفاءة والخبرة والمهارة وبشكل عام فإنه يتمتع أعضاء الفريق بحرية تامة في كيفية تحقيق هذه الأهداف.
الصدق : أن القائد لا يغير أسلوبه لمجرد تغيير الموقف، بل المطلوب منهم ببساطة التكيف بطريقة هي الأنسب مع مراعاة عوامل مثل مستوى نضج التابعين والهيكل التنظيمي والثقافة المنظمة، والأهداف التي يتعين تحقيقها، ويجب القيام بذلك بأمانة تامة، ([28]) .
العزيمة : يتطلب الأمر الكثير من الشجاعة للقائد لتجربة مناهج القيادة المختلفة ومعرفة أيها مثالي، لكن القائد الموقفي شجاع بما يكفي لأخذ الفرص واعتماد أسلوب قيادة مختلف تمامًا إذا تطلب الموقف ذلك.
الرؤية الواضحة:يلزم أن يكون لدى القائد الموقفي رؤية واضحة لكيفية قيادة وتطوير وتوجيه الفريق،وهنا يكون بإمكان القائد تحديد واكتساب سلوكيات واستراتيجيات فعالة لتحقيق الأهداف المنشودة.
التواضع : القائد الموقفي إنسان يتعرض للمواقف المختلفة والكفيلة بمنحة الخبرة في كل مجال ، لذلك فإن أسلوب القائد الموقفي يكون متواضع وقادر على تقبل أوجه القصور في أسلوب قيادته.
تاسعا : متطلبات الإدارة الموقفية :
1- الأساليب القيادية :
تقدم أساليب القيادة الموقفية مجموعة من الحلول لمواجهة ضعف استجابة العاملين للخطط التي تطرحها الإدارة العليا لمواجهة الأزمات التي تتعرض لها المنظمات وبعد Fieldler) Frederic ) من جامعة الينوي الأمريكية أول من قدم محاولة جادة لتطوير إطار نظري للقيادة يأخذ في الاعتبار تفاعل بعض متغيرات الموقف وخصائص القائد، وطرح أسلوبين في القيادة أحدهما يهتم بالعاملين والعلاقات الإنسانية (أسلوب المشارك)، الثاني يهتم بالإنتاج والعمل (الأسلوب الموجه) ([29]).
- التخطيط الموقفي :
إن القيادة الموقفية وارتباطها بمتغير التخطيط الموقفي يرتكز على أربع متغيرات أساسية تساهم في تشكيل مفهوم التخطيط للقيادة الموقفية وتلك المتغيرات هي التوجيه، التدريب، الدعم ، والتفويض. بالنسبة للتوجيه، فيعتبر نهج القيادة هذا أكثر ملاءمة عندما لا يستطيع هؤلاء الأفراد القيام بالمهمة نتيجة لعدم استعدادهم([30]).
أما بالنسبة للتدخل فإنه يكون مطلوب من القادة الموقفيين الموجهين التدخل في حالة التنبؤ أو الاحتمال بحدوث مخاطرة ما لها عواقب وخيمة وبالتالي ضمان أقل قدر من الخسائر ([31]).
أما التدريب كأحد مناهج القيادة الموقفية فإنه يعتبر نهج القيادة هذا أكثر ملاءمة عندما يكون لدى الأفراد العاملين رغبة كبيرة بإتمام المهام الموكلة إليهم ولكن قدرات ومهارات منخفضة لإتمامها، تماما كما التوجيه ولكن باختلاف مستوى الرغبة، في هذه الحالة فإنه يكون مطلوبًا من القائد الموقفي يساعدالفرد على اكتساب المهارات اللازمة للقيام بالمهمة بشكل مستقل في المرة القادمة([32]).
أما بالنسبة للدعم ، يعتبر نهج القيادة هذا أكثر ملاءمة عندما يكون لدى الأتباع رغبة منخفضة ولكن لديهم قدرة عالية على المهمة المطروحة، إلا أنه سيكون مطلوبًا منه أن يحسن التصرف من ناحية الاستماع وإعطاء الثناء وجعل الأفراد العاملين يشعرون بالرضا ([33]).
المحور الثاني : ماهية التعليم الأزهري ما قبل الجامعي ؟
أولاً: نشأة التعليم الأزهري في مصر وتطوره.
في الرابع والعشرين من جمادى الأولى لسنة (359هـ – 970م) أرسى جوهر الصقلي قائد الدولة الفاطمية قواعد الجامع الأزهر، وأستغرق البناء ما يزيد عن العامين قليلاً، وأقيمت فيه الصلاة لأول مرة في يوم الجمعة السابع من شهر رمضان عام (361هـ – 972م) فكان أول مسجد جامع للدولة الفاطمية رمزاً لسيادتها الدينية، يتلقى فيه الطلاب مذهب الدولة الحاكمة المتمثل في المذهب الإسماعيلي الشيعي ليتحقق له الانتشار بين الناس.
ولقد مر التعليم الأزهري على مدار تاريخه الطويل بفترات ازدهار ثقافي، وفترات تدهور وركود أيضاً، فعلى حين يعتبر العصر الأيوبي مثلاً من فترات ازدهاره، يعتبر العصر العثماني من فترات تدهوره وركوده، وفي عهد محمد على تم إهمال التعليم الأزهري، ومع ذلك فإن الأقبال على هذا التعليم لم يتأثر، نظراً لما كان يتمتع به هذا التعليم وعلماؤه من هيمنة على نفوس الجماهير في مصر وغيرها من الدول الإسلامية، وعلى الرغم من أن التعليم الحديث كان يحظى بعناية الدولة ورعايتها، ويجد الأموال الكافية لشئونه، إلا أن الأزهر احتفظ إلى حد كبير في هذا العهد بإقبال ورغبة أكثر لدى الناس، ففي الوقت الذي كانت فيه الدولة تجبر الطلاب على الالتحاق في مدارسها وتلجأ إلى طريقة التجنيد كان الطلاب يذهبون إلى الأزهر والكتاتيب الملحقة به باختيارهم دون ضغط أو قسر([34]).
ثانياً: القوانين والهيئات المسئولة عن إدارة التعليم الأزهري:
لقد كانت الدراسة في الأزهر منذ وجد حرة طليقة من كل قيد، أي لم يكن للأزهر طوال الفترة السابقة قانون يقيد نظام الدراسة فيه بنظام معين، ولم توجد تحديات سنية، ولا مراحل تعليمية في الدراسة في الأزهر قديماً، ولذلك وجد تناقض هائل في الحلقة الدراسية إذ يجلس طلاب أعمارهم في العاشرة مع طلاب أعمارهم في الثلاثين، فصغار السن يصعب عليهم فهم المتون، وكبار السن يضيقون ذراعاً بمثل هؤلاء الصغار، ولما زاد عدد الطلاب وتقدمت الدراسة، وتنوعت العلوم، واتسع نطاق الأزهر، ومع مجيء القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بدأ نظام التعليم الحديث في مصر يتبلور، وبدأت فكرة الجامعات الحديثة فكان على الأزهر ومؤسساته التعليمية المختلفة أن يعيد تطوير نفسه تنظيمياً ومنهجياً، فصدرت مجموعة قوانين متتالية لتنظيم الأزهر ومؤسساته وتنظيم المراحل الدراسية، والعملية التعليمية في الأزهر ومن ثم تطوير الدراسة فيه([35]).
أما الهيئات التي يتكون منها الأزهر فهي([36]):
1- المجلس الأعلى للأزهر:
وهو المسئول عن توجيه كافة شئون الأزهر، والتخطيط لأنواع النشاط في هيئاته المختلفة، ومتابعة تنفيذ سياسة البحث وسياسة التعليم في أجهزته المختلفة، ويتكون من: شيخ الأزهر وله رئاسة المجلس – وكيل الأزهر – رئيس جامعة الأزهر – عمداء كليات جامعة الأزهر – ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي – أربعة من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية – الوكلاء المساعدين في وزارات الأوقاف والتعليم والعدل – مدير الثقافة والبحوث الإسلامية – مدير المعاهد الإسلامية.
2- مجمع البحوث الإسلامية:
وهو الهيئة العليا للبحوث الإسلامية، ويقوم بالدراسة في كل ما يتصل بهذه البحوث، ويعمل على تجويد الثقافة الإسلامية، وحمايتها من آثار التعصب المذهبي والسياسي، وكذلك تتبع كل ما ينشر عن الإسلام والتراث العربي والإسلامي من بحوث الأجانب ودراساتهم للانتفاع بها إن كانت صحيحة، أو مواجهتها بالتصحيح والرد عليها.
3- إدارة الثقافة والبعوث الإسلامية: هي الجهاز الذي يهيئ لمجمع البحوث الإسلامية كل أسباب البحث والدراسة، كما تقوم بالإعداد والتحضير لهذ البحوث والدراسات، وتحمل المسئولية كاملة للمتابعة والتنفيذ، كما تتحمل مسئولية إعداد وتنفيذ مشروعات البعوث من وإلى الأزهر.
4- جامعة الأزهر:
تختص بكل ما يتعلق بالتعليم العالي الأزهري، وبالبحوث التي تتصل بهذا النوع من التعليم، كما تهتم ببعث التراث العلمي والفكري للشعوب.
5- المعاهد الأزهرية:
فإنه لكي يعد لكليات الجامعة الأزهرية على اختلاف أنواعها، طلاب على حظ من الثقافة الإسلامية والعربية، إلى جانب المعارف والخبرات التي تتيح لهم الاستمرار في الدراسات الجامعية،وضع نظام المعاهد الأزهرية،ولقد قسمت اللائحة التنفيذية المعاهد الأزهرية إلى قسمين:
أ- المعاهد الأزهرية العامة: وتشمل المعاهد والإعدادية والثانوية.
ب- المعاهد الأزهرية الخاصة: وتشمل معهد البحوث، ومعاهد القراءات، ومعاهد الفتيات، والمعاهد النموذجية.
ثالثًا : أهداف التعليم الأزهري قبل الجامعي :
والأهداف تمثل فوق ذلك شكلاً من أشكال التعهد والالتزام الإداري بتحقيق نتائج محددة, أو الوصول الي مستويات معينة من الإنجازات, والأهداف دعوة الي التصرف الفاعل, وتحويل الطموحات الي واقع ملموس([37]) . لأنها تساعد علي اتخاذ القرارات, حيث تعد الأهداف دليلا أو مرشدا للإدارة العليا في اتخاذ القرارات الملائمة بما يتناسب والمواقف التي تواجهها، فأهداف التعليم الأزهري هي نفس أهداف التعليم العام, ولكنها تنفرد عنها في الخصوصية التي يتميز بها الأزهر الشريف عن غيره من أنواع التعليم الأخرى , وإذا كانت أهداف التربية الإسلامية تشتق من الإسلام, وتعمل علي تحقيق أهدافه , سواء كانت التربية في المدرسة أو خارجها , فإن فلسفة الأزهر تنبع من فلسفة الإسلام([38]).
ولقد حدد القانون رقم (103) لسنه (1961م) , الأسس والمبادئ والمتطلبات التي ينبغي علي التعليم الأزهري الارتكاز عليها, ومراعاتها والذي يهدف إلى تكوين المواطن الصالح, ومساعدة الفرد علي اكتساب سمات وصفات المواطن الصالح المستنير([39]) .
والأزهر ليس مجرد معهد يعد أبناءه للسير في ركب الحياة, أو ليضطلعوا بمهنة من مهن العيش ولكنه إلي جانب ذلك يعدهم ليكونوا أصحاب دعوة, ورسل هداية بين أقوامهم , وليسهموا في بناء المجتمع الإسلامي علي أسس من العقيدة والشريعة ([40]) .
وقد ذكرت نتائج إحدى الدراسات إلى أن أهداف التعليم الأزهري قبل الجامعي هي نفس أهداف التعليم العام، بالإضافة إلى حفظ القران الكريم وفهمه، وأن هناك أهدافا لا تتحقق بالصورة الكافية في مرحلة التعليم الأزهري([41]).
- المناهج وخطة الدراسة.
وقد وضع القائمون علي التعليم الأزهري نصب أعينهم عند وضع خطط الدراسة بالمعاهد الأزهرية عدة اعتبارات، أهمها الربط بين التعليم الأزهري والتعليم العام، وذلك بتزويد التلاميذ بالأزهر بالقدر نفسه من العلوم الحديثة التي يحصل عليها تلاميذ التعليم العام، مع الإبقاء علي المواد العربية والدينية بوزنها وثقلها حفاظا علي تراث الأزهر واعترافا بأن هذه الدراسات الدينية والعربية هي الميزة الكبرى التي تميز التعليم الأزهري عن غيره من أنواع التعليم، وقد سبق ذكر أن مناهج المواد الثقافية قد أخذها الأزهر عن مناهج التربية والتعليم منذ عام التطوير (1961) وبقيت إلي الآن لا تتغير ولا تتبدل إلا مع متغيرات وزارة التربية والتعليم وتعديلاتها، ويعتمد في أدائها علي الكتب التي تؤلفها وزارة التربية والتعليم لطلابها، وتمد بها المعاهد الأزهرية كل عام ([42]) .
أهم نتائج البحث:
من خلال إستعراض المحورين السابقين توصل البحث الى عدة نتائج ، من أهمها:
1- يعانى التعليم قبل الجامعى الازهرى من أوجه قصور عديدة نتيجة تطبيق الإدارة المركزية: منها(الروتين والبيروقراطية الإدارية والبطء في اتخاذ القرار، والحد من الإبداع والابتكار في العملية التعليمية، وعدم تفويض السلطات الإدارية، والازدواجية في تنفيذ المهام، وغيرها).
2- لتطبيق الإدارة الموقفية فى التعليم فبل الجامعى الازهرى مميزات عديدة ، منها:
1-أن القائد الإداري عليه أن يعرف أساليب القيادة المختلفة ويتعين عليه اختيار الأشخاص المناسبين للقيادة بأسلوبه.
2-يجب على القائد أن يختار أسلوب القيادة المناسب للوضع المعين الذى من شأنه أن يزيل الحاجة إلى إتباع استراتيجية صارمة في جميع الأوقات وأن يكون لديه القدرة على فهم الموقف منحوله([43]).
3-تعطي الفرصة للقائد الإداري تشكيل أسلوب قيادته بما يتناسب ومستوى استعداد الفريق واحتياجاته الأمر الذى من شأنه التأثير على أداء الفريق لأن القائد يستخدم أسلوبًا يحفز الموظف ويحسن أدائه([44]).
4-يكون القائد الإداري قادرًا على نهج القيادة المختار بطريقة تساهم في قيادة الفريق وتطوير مستواه في نفس الوقت.
5-لديها أثر فعال في زيادة الوعي، حيث يجب أن يكون قادة الموقف على دراية بما يحدث من حولهم من خلال زيادة وعيهم.
6-يكون القائد الإداري متوافقًا مع أهداف المؤسسة وأن يكون مدركًا تمامًا للخطوات التى يجب اتخاذها للوصول إلى الأهداف([45]).
3-توصل البحث فى نهايته الى تصور مقترح لأهم متطلبات تطبيق الإدارة الموقفية فى التعليم قبل الجامعى الازهرى، يمكن بيانه كما يلى :
المحور الثالث: التصور المقترح لأهم متطلبات تطبيق الإدارة الموقفية فى التعليم قبل الجامعى الازهرى :
ما متطلبات تطبيق الإدارة الموقفية في التعليم الأزهري ما قبل الجامعي؟
من خلال استعراض المحورين السابقين يمكن تقديم بعض المتطلبات الازمه لتطبيق الإدارة الموقفية في التعليم الأزهري قبل الجامعي وهى كالتالي :
واقع متطلبات تطبٌق الإدارة الموقفٌة
: البعد الأول: متطلبات خاصة بالأهداف: وتتمثل فيما يلى:
أ_ أهداف معرفٌية:
1 _القدرة علً الانتقال من اسلوب قٌاده الى اخر.
2_ القدرة على تلبٌية الاحتياجات المتغيرة للمعهد وموظفٌيه.
3_ تعرف المعلمين بأهمية اكتشاف الطلبة الموهوبين باستمرار.
4 _تساعد الأهداف على التعرف على اسلوب الإدارة.
5 _القدرة على وضع سناريوهات مستقبلٌيه لإدارة الآزمة.
6_القدرة على قٌياس وتقٌييم المخاطر وتطور استراتٌيجٌيات لنقل المخاطر الى جه اخرى لتجنب وتقلٌيل اثارها السلبٌة.
7_التعرف على تفسيٌر الأمور داخل المؤسسة الأكاديمية مما ٌيساعد فًي تكوٌين الخبرات التي تمكن من اتخاذ وتنفٌذ القرارات الازمه .
8_ان ٌيتعرف المعلمٌين على اهمٌية تكوٌين فرق عمل متخصصه للتقٌييم .
السرٌيع والدقٌيق لمخاطر القرارات الارتجالية.
ب -اهداف وجدانٌية:
9 _أن ٌيشعر العامليٌن بأهمٌية الادارة.
10 _أن يٌحب العامليٌن تنفٌذ المهام.
11_ أن ٌيؤمن العاملٌين بمسؤوليٌتهم تجاه المؤسسة.
12 _ان ٌيشعر الطلبة بأهمٌية التفوق باستمرار.
13 _ان ٌيحس الطلبة بأهمٌية الابداع باستمرار.
14_ ان ٌيؤمن الطلبة بتطوٌر انفسهم باستمرار.
ج_ اهداف مهارٌة:
15_يمتلك العاملٌين القدرة على معالجة مشكلات الطلبة أولا بأول.
16_يمتلك العاملٌين القدرة على بناء حل سرٌيع للمشكلات المفاجئة التي تواجه المؤسسة من خلال الاعتماد على مواردها المتاحة.
17_ القدرة على الابتكار والابداع والتوصل الى حلول جدٌده وغٌير مألوفه.
18_ تمتلك ادارة المعهد القدرة على تنميٌة مهارات الطلبة وفق أسس علمٌية.
19_تمتلك ادارة المعهد القدرة على حل المشكلات و المرونة لفهم متى يغيٌرون اسلوبهم في الإدارة.
20_تمتلك ادارة المعهد القدرة على تزويٌد الطلبة بمجموعة من المهارات تساعدهم على العمل فً المٌياديٌن المختلفة فًي المستقبل.
البعد الثاني :متطلبات خاصة بالتخطٌيط: وتتمثل فيما يلى:
21_تضع بدائل واستراتٌيجٌيات إدارٌية بدٌيلة للمواقف المتعددة.
22 _تقوم مع اعضاء فرٌيق الازمات بإجراء مسح كامل لموارد المؤسسة.
23_تقوم على رصد ومراقبة البٌيئة الداخلٌة والخارجٌية والتغٌيرات التي تشٌير بوقوع أزمة داخل المؤسسة .
24 _تقوم على وضع سيٌنارٌيوهات مستقبلٌية لإدارة الازمة.
25_ توفر قاعدة المعلومات والتعلٌيمات التًي بتطلبها التعامل مع الازمة .
26_تحث العامليٌن على التعاون مع الفرٌيق مع تقديٌم المقترحات لوقف انتشار الازمه.
27_تقوم إدارة التعلٌم الأزهري قبل الجامعي بتقدٌيم التوجٌيهات الواضحة لما هو متوقع عمله من قبل العاملٌين.
28_ تنمى قٌيم التعاون بٌين جمٌيع العاملٌين
29_ تقدم توضٌيحات حول الانظمة والتعلٌيمات المعمول بها.
30_ توضح للعاملٌين بالمعهد المهام المراد انجازها داخل المعهد.
31_يحرص على انجاز العمل فًي الوقت المناسب.
32_تلتزم بالتعلٌيمات المدرسٌية عند انجاز العمل.
33 _تهتم أن ٌيكون المعهد له صورة إٌيجابٌية باستمرار.
34 _تشجع العامليٌن على الابداع فً مجال العمل.
البعد الثالث: متطلبات خاصة بالتنفيذ: وتتمثل فيما يلى :
35_افراد ٌيؤمنون بالتغٌيير.
36 _تعاون بٌين العامليٌن والمسؤولٌين.
37_ مشاركة بٌين العاملٌين.
38_ اصدار القرار.
39_ تنفٌيذ القرار.
40-وضع الٌيات تساعد على التنفٌيذ.
41_ النظر فًي الجانب التنفٌيذي فًي الادارة.
42_رصد ومراقبة البيٌئة الداخلٌية والخارجٌية والتغٌيرات التي تشٌير بوقوع أزمة داخل المؤسسة .
43 _تحدد الازمات المحتملة فًي ضوء القيٌم والمتغٌيرات البٌيئيٌة .
44 _وضع سٌيناريٌوهات مستقبلٌية لإدارة الأزمة.
45_ توفر قاعدة المعلومات والتعلٌيمات التي بتطلبها التعامل مع الأزمة .
46 _تعاون العاملٌين مع الفرٌيق مع تقدٌيم المقترحات لوقف انتشار الازمة.
البعد الرابع: متطلبات خاصة بالإدارة: وتتمثل فيما يلى :
47_الإستعانة بخبراء لتوعٌية العاملٌين
48_عقد ندوات عن اهمٌية تطبٌيق الإدارة الموقفيٌة
49_ توفٌير مٌيزانٌية
50_ تقوم بمعالجة المواقف تبعا لطبٌيعتها.
51_ تقوم بتنفيٌذ المهام بطرق متعددة تتوائم مع الموافق المختلفة.
52_ تتسم بالمرونة فًي تنفيٌذ المهام تبعا لطبٌيعتها.
53_ تستخدم أساليٌب وأنماط قٌيادٌيه متعددة تبعا للمواقف والظروف.
54_ تعطى الحرٌية للعامليٌن فًي اختٌيار الطرٌيقة المناسبة لتنفيٌذ مهامهم.
55_ تقوم بتطبيٌق التعلٌيمات الإدارية بمرونة تبعا للمواقف المختلقة.
56_ تعمل على إٌيجاد بٌيئة عالٌية التحفٌيز ومناخ مناسب للعمل.
57_تقوم بوضع الإشارات التحذٌيرٌية التًي تنذر بقرب وقوع الأزمة كأسالٌيب وقائٌية.
58_ تعمل على وضع سٌينارٌيوهات مستقبلٌيه لإدارة الأزمة
مراجع البحث
أ- المراجع العربية.
1_احمد ابراهيم احمد الادارة المدرسية في الالفية الثالثة الاسكندرية : مكتبة المعارف الحديثة، 2002.
2_احمد نجم الدين احمد عيدا روس ادارة عملية التخطيط الاستراتيجي كمدخل لفاعلية الادارة المرتكزة الى المدرسة تصور مقترح ننحو تطبيق بنيوية الفيدرالية الادارية بمؤسسات التعليم العام"، مجلة دراسات تربوية واجتماعية، عدد 4 مجلد 11 ، أكتوبر 2005، جامعة حلوان.
3_امال سید محمد مسعود متطلبات تحقيق الاستقلال الذاتي للمدرسة الثانوية العامة في ضوء لامركزية التعليم"، مجلة مستقبل التربية العربية المركز العربي للتعليم والتنمية القاهرة، ع (66) مج (17)، سبتمبر 2010.
4-ايمن محمد البيومي دراسة تحليلية لبعض نماذج تطوير المدارس ومدي امكانية تطبيقها في المدراس المصرية " رسالة ماجستير، كلية التربية جامعة الاسكندرية ، 2006.
5_تقرير التنمية البشرية، القاهرة في
Available at2004 http://www.undp.org.eg.2/12/2019
6-حنان فؤاد محمد بحر، الجودة الشاملة في التعليم الأساسي، نموذج مقترح"، رسالة دكتوراه، كلية البنات جامعة عين شمس، 2002.
7-خميس فهيم عبد الفتاح عبد العزي الادارة الذاتية للمدرسة في الفكر الاداري المعاصر ومتطلبات تطبيقها في المدارس الثانوية "بمصر" دراسة تحليلية "، رسالة ماجستير كلية التربية بدمنهور، جامعة الاسكندرية، 2005 م.
8_رشيد خالد راشد منصور "المركزية واللامركزية في الادارة التربوية في فلسطين من وجهة نظر مديري ومديريات المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الفلسطينية "، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين، 2004م
9-زينب احمد محمد سليمان استراتيجية مقترحه لتفعيل اللامركزية في ادارة التعليم الأساسي في ضوء خبرات بعض الدول دراسة ميدانية في محافظة اسيوط"، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة اسيوط، 2016
10-عبدالحميد عبد الفتاح عبد الحميد اللامركزية كمدخل لفاعلية جودة عملية صنع القرار المدرسي في مصر"، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة بنها، 2007.
11-محمد ابراهيم محمد خليل "اللامركزية التعليم في مصر بين النظرية والتطبيق: دراسة ميدانية علي محافظة البحيرة"، مجلة مستقبل التربية العربية، المركز العربي للتعليم والتنمية ، القاهرة ، ع (19) ، م ج (18) ، مارس 2011.
12-ناصر محمد عامر، تفعيل اللامركزية بالمدار المصرية في ضوء خبرات بعض الدول الاجنبية "، التربية : مجلة علمية متخصصة، الجمعية المصرية للتربية المقارنة والادارة التعليمية، القاهرة، ع (20) اغسطس 2006.
13_نبيل سعد خليل دراسة" مقارنة للإدارة التعليمية في كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وإمكانية الافادة منها في مصر " ، مجلة علمية متخصصة، الجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة.
ب- المراجع الاجنبية :-
([1]) حنان فؤاد محمد بحر، الجودة الشاملة في التعليم الأساسي، نموذج مقترح ، رسالة دكتوراه، كلية البنات، جامعة عين شمس، 2002، ص1.
([2]) زينب احمد محمد سليمان استراتيجية مقترحه لتفعيل اللامركزية في ادارة التعليم الأساسي في ضوء خبرات بعض الدول، دراسة ميدانية في محافظة اسيوط"، رسالة ماجستير، كلية التربية جامعة اسيوط، 2016، ص3.
([3]) احمد ابراهيم احمد الادارة المدرسية في الالفية الثالثة الاسكندرية: مكتبة المعارف الحديثة، 2002، ص 156 .
([6]) تقرير التنمية البشرية، القاهرة،2004 Available at: http://www.undp.org.eg.2/12/2019.
([8]) محمد ابراهیم محمد خليل، لامركزية التعليم في مصر بين النظرية والتطبيق : دراسة ميدانية علي محافظة البحيرة"، مجلة مستقبل التربية العربية، المركز العربي للتعليم والتنمية القاهرة، ع (19) ، م ج (18) ، مارس 2011، ص ص 380- 479 .
([9]) امال سید محمد مسعود، متطلبات تحقيق الاستقلال الذاتي للمدرسة الثانوية العامة في ضوء لامركزية التعليم"، مجلة مستقبل التربية العربية المركز العربي للتعليم والتنمية، القاهرة، ع (66) مج (17) ، سبتمبر ، 2010، ص ص 13_39 .
([10]) عبدالحميد عبد الفتاح عبدالحميد اللامركزية كمدخل لفاعلية جودة عملية صنع القرار المدرسي في مصر"، رسالة ماجستير، كلية التربية جامعة بنها، 2007 .
([11]) ايمن محمد البيومي ، دراسة تحليلية لبعض نماذج تطوير المدارس ومدي امكانية تطبيقها في المدراس المصرية "، رسالة ماجستير، كلية التربية جامعة الاسكندرية ، 2006 .
([12]) ناصر محمد عامر، تفعيل اللامركزية بالمدار المصرية في ضوء خبرات بعض الدول الاجنبية، التربية: مجلة علمية متخصصة، الجمعية المصرية للتربية المقارنة والادارة التعليمية القاهرة، ع (20) ، اغسطس 2006، ص ص 107_197 .
([13]) احمد نجم الدين احمد عيدا ،روس ادارة عملية التخطيط الاستراتيجي كمدخل لفاعلية الادارة المرتكزة الى المدرسة نتصور مقترح ننحو تطبيق بنيوية الفيدرالية الادارية بمؤسسات التعليم العام، مجلة دراسات تربوية واجتماعية، عدد4 ، مجلد 11، اکتوبر 2005، جامعة حلوان، ص ص 219 – 289 .
([14]) خميس فهيم عبد الفتاح عبد العزي، الادارة الذاتية للمدرسة في الفكر الاداري المعاصر ومتطلبات تطبيقها في المدارس الثانوية بمصر" دراسة تحليلية "، رسالة ماجستير ، كلية التربية بدمنهور جامعة الاسكندرية 2005م، ص ص 3-8 .
([15]) رشيد خالد راشد منصور "المركزية واللامركزية في الادارة التربوية في فلسطين من وجهة نظر مديري ومديريات المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الفلسطينية" ، رسالة ماجستير كلية الدراسات العليا جامعة النجاح الوطنية نابلس، فلسطين، 2004م ، ص ص 15-141 .
([16]) نبيل نبيل سعد خليل،" دراسة مقارنة للإدارة التعليمية في كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وامكانية الافادة منها في مصر"، مجلة علمية متخصصة، الجمعية المصرية للتربية المقارنة والادارة التعليمية السنة (6) عدد (9)، يونيه 2003 م، ص ص 77-146 .
([17]) Bjork, Local, Responses to Decentralization Policy in Indonesia, comparative Education Review, 2003, Vol. 47, No. 2. PP. 184-216.
([18]) Adolfo Merino Juarez Gustavo: Federalism and the Policy Process: Using basic education as a test case of decentralization in Mexico, Diss. Abs.Int. Vol6161,2000.p292.
([19]) خلف عابد محمد الطعجان ، درجة تطبيق مديري المدارس الحكومية في لواء البادية الشمالية الشرقية لمبادئ الإدارة الموقفية من وجهة نظر المعلمين، المجلة التربوية الدولية المتخصصة، مج (3)، ع (11)، دار سمات للدراسات والأبحاث، 2014، ص 103.
([20]) أبو الحسن عبد الموجود ، التطوير الإداري في منظمات الرعاية الاجتماعية، المكتب الجامعي الحديث،2007، ص15.
([21]) قاموس المعاني، http://www.almaany.com/home.php?language-arabic&Lang-name .
([23]) Nobles, M., & Fraizer, L. : Assuming a Leadership Role: Exploring Situational Leadership Strategies for Supporting and Mentoring Graduate Student Teaching Assistants in Anatomy and Physiology HAPS Educator, 21(3), 2017, P. 41.
([24]) Samosudova, N. V. (2017). Modern leader ship and management methods for development organizations. In MATEC Web of Conferences (Vol. 106, p. 08062). EDP Sciences, 2017, P.62
([25]) قاسم شاهين العمري ، أنماط القيادة الإدارية وتأثيرها في إنجاح المنظمات الحكومية، أطروحة دكتوراه، دراسة تحليلية، كلية الإدارة والاقتصاد جامعة سانت كليمنتس، 2009،ص24.
([26]) ماجد عبد المهدي المساعدة ، ادارة الازمات، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2012، ص276.
([27]) Imron, A., Satria, R., & Puspitaningtyas, I , Implementation of Situational Leadership in Educational Organizations. In the 4th International Conference on Education and Management (COEMA 2019). Atlantis Press, P.19.
([28]) غفران محمود التيمة ، درجة ممارسة القيادات الأكاديمية النسائية الإدارية بالجامعات الأردنية لأنماط القيادة الموقفية وعلاقتها بالاحتراق النفسي لدى مرؤوسيهن، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الهاشمية، الزرقاء، 2010، ص 42 .
([30]) Alobaidan, L., Kee, D. M. H., Hanif, M., Afifi, M., AlFouzan, S., Tan, P. H. ,….. & . Quttainah,M. A How Does Situational Leadership Affect M Organizational Success? A Study of Honda. Advances in Global Economics and Business Journal, 1(1), 2020, p. 32
([31]) Ali, W. A Review of Situational Leadership Theory and Relevant Leadership Styles : Options for Educational Leaders in the21st Century. Journal of Advances in Social Science and Humanities , 3(11), 2017, P.35
([32]) Hassan, A., Zain, Z. M., & Ajis, M. N. I. Social integration in post conflict Somalia: implications for a situational leadership style framework. Asian Journal of Multidisciplinary Studies, 7(3), 2019, P.27.
([33]) Vidyakala, K. A Conceptual Study on Situational Leadership Approach. PURAKALA, 31(19), 2020, P. 44.
([34]) سعيد إسماعيل على, الأزهر على مسرح السياسة المصرية دراسة في تطور العلاقة بين التربية والسياسة، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، 1974، ص 163.
- رمضان موسى محمد , مكتبات المعاهد الأزهرية بمصر، دراسة تطبيقية على مكتبات المعاهد الثانوية الأزهرية بمحافظتي القاهرة والمنوفية، رسالة ماجستير، كلية الآداب بشبين الكوم، جامعة المنوفية، 2003، ص 14.
- الأزهر، وزارة الأوقاف وشئون الأزهر, الأزهر تاريخه وتطوره، مرجع سابق، 1964، ص 243.
- رئاسة الجمهورية , تقرير المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا، التعليم الأزهري، الدورة السابعة والعشرون.
- المجالس القومية المتخصصة , التعليم الأزهري، "تقرير المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا"، التعليم الأزهري، القاهرة، الدورة (27)، 2000، ص 207.
- وزارة الأوقاف وشئون الأزهر , الأزهر تاريخه وتطوره، مرجع سابق، ص ص 304-307.
- عادل فوزي رجب , تطوير صناعة القرار بقطاع المعاهد الأزهرية في ضوء الفكر الإداري المعاصر، رسالةدكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة الأزهر، 2014، ص 141.
([37]) ماجد عبد المهدي مساعدة, إدارة المنظمات منظور كلي , دار المسيرة للنشر والتوزيع, الأردن, عمان، 2015، ص 85 .
([38]) زكريا مطلق الدوري , الادارة الاستراتيجية مفاهيم وعمليات وحالات دراسية , دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع , عمان الأردن , 2013، ص 58.
([39]) المجالس القومية المتخصصة, دور الأزهر في تكوين المواطن الصالح، المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا، القاهرة، الدورة الثامنة والعشرون، 2000/2001, ص 273 .
([40]) المجالس القومية المتخصصة , سياسة القبول في المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر ، المجلس القومي للتعليموالبحث العلمي والتكنولوجيا, القاهرة، الدورة الحادية عشر , المجلد الثامن , المجلد الثامن، 1984, ص 67 .
([41]) خالد عبدالرحمن ياسين أحمد , دور المعاهد الأزهرية في البناء الخلقي لتلاميذها مع الإشارة إلي العوامل المؤثرة فيه , رساله غير منشورة , كلية التربية بسوهاج , جامعة جنوب الوادي، 2005, ص 197.
([42]) المجالس القومية المتخصصة , خطة الدراسة والمناهج بالمعاهد الأزهرية، المجلس القومي والبحث العلمي،: الدورة السابعة عشر، المجلد الثامن , 1990، ص ص 129 – 130 .
([43])Hottinger, J. M. : Utility of Situational Leadership to Retail
Managers (Doctoral dissertation, Pepperdine University), 2018, P. 15.
مراجع البحث
أ- المراجع العربية.
1_احمد ابراهيم احمد الادارة المدرسية في الالفية الثالثة الاسكندرية : مكتبة المعارف الحديثة، 2002.
2_احمد نجم الدين احمد عيدا روس ادارة عملية التخطيط الاستراتيجي كمدخل لفاعلية الادارة المرتكزة الى المدرسة تصور مقترح ننحو تطبيق بنيوية الفيدرالية الادارية بمؤسسات التعليم العام"، مجلة دراسات تربوية واجتماعية، عدد 4 مجلد 11 ، أكتوبر 2005، جامعة حلوان.
3_امال سید محمد مسعود متطلبات تحقيق الاستقلال الذاتي للمدرسة الثانوية العامة في ضوء لامركزية التعليم"، مجلة مستقبل التربية العربية المركز العربي للتعليم والتنمية القاهرة، ع (66) مج (17)، سبتمبر 2010.
4-ايمن محمد البيومي دراسة تحليلية لبعض نماذج تطوير المدارس ومدي امكانية تطبيقها في المدراس المصرية " رسالة ماجستير، كلية التربية جامعة الاسكندرية ، 2006.
5_تقرير التنمية البشرية، القاهرة في
Available at2004 http://www.undp.org.eg.2/12/2019
6-حنان فؤاد محمد بحر، الجودة الشاملة في التعليم الأساسي، نموذج مقترح"، رسالة دكتوراه، كلية البنات جامعة عين شمس، 2002.
7-خميس فهيم عبد الفتاح عبد العزي الادارة الذاتية للمدرسة في الفكر الاداري المعاصر ومتطلبات تطبيقها في المدارس الثانوية "بمصر" دراسة تحليلية "، رسالة ماجستير كلية التربية بدمنهور، جامعة الاسكندرية، 2005 م.
8_رشيد خالد راشد منصور "المركزية واللامركزية في الادارة التربوية في فلسطين من وجهة نظر مديري ومديريات المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الفلسطينية "، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين، 2004م
9-زينب احمد محمد سليمان استراتيجية مقترحه لتفعيل اللامركزية في ادارة التعليم الأساسي في ضوء خبرات بعض الدول دراسة ميدانية في محافظة اسيوط"، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة اسيوط، 2016
10-عبدالحميد عبد الفتاح عبد الحميد اللامركزية كمدخل لفاعلية جودة عملية صنع القرار المدرسي في مصر"، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة بنها، 2007.
11-محمد ابراهيم محمد خليل "اللامركزية التعليم في مصر بين النظرية والتطبيق: دراسة ميدانية علي محافظة البحيرة"، مجلة مستقبل التربية العربية، المركز العربي للتعليم والتنمية ، القاهرة ، ع (19) ، م ج (18) ، مارس 2011.
12-ناصر محمد عامر، تفعيل اللامركزية بالمدار المصرية في ضوء خبرات بعض الدول الاجنبية "، التربية : مجلة علمية متخصصة، الجمعية المصرية للتربية المقارنة والادارة التعليمية، القاهرة، ع (20) اغسطس 2006.
13_نبيل سعد خليل دراسة" مقارنة للإدارة التعليمية في كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وإمكانية الافادة منها في مصر " ، مجلة علمية متخصصة، الجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة.
ب- المراجع الاجنبية :-