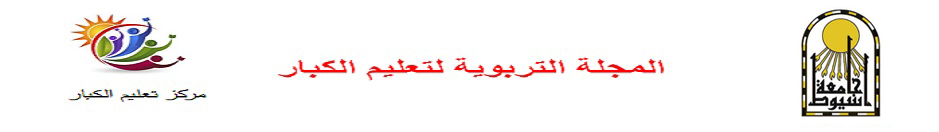
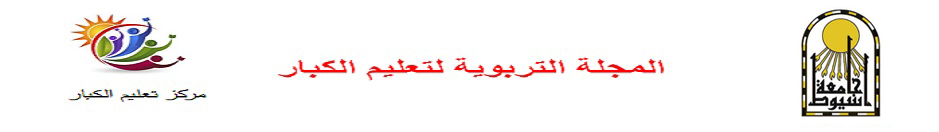
نوع المستند : أوراق بحثیة
المؤلفون
1 كلية التربية- جامعة اسيوط
2 كلية التربية-جامعة أسيوط
المستخلص
الكلمات الرئيسية
الموضوعات الرئيسية
كلية التربية
كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
المجلة التربوية لتعليم الكبار– كلية التربية – جامعة أسيوط
=======
تنمية المواطنة الرقمية لطلاب المدرسة الإعـدادية
. (دراسة تحليلية)
تحــــت إشــــــــــــــــــراف
|
د/ ثابت حمدي قنديل |
أ.د/ عـمر محمد محمد مرسي |
|
مدرس التربية المقارنة والإدارة التعليمية كلية التربية - جامعة أسيوط |
أستاذ أصول التربية والتخطيط التربوي ومدير مركز تعليم الكبار بكلية التربية كلية التربية - جامعة أسيوط |
بحث مقدم من
الباحث / كـميل جـميل حنا
معـلم أول أ لغة فرنسـية
بمدرسة المنشاه الكبري التجارية – القوصية
} المجلد السادس – العدد الثانى – أبريل 2024م {
المستخلص
هدفت الدراسة إلى تعرف دور مدارس التعليم الإعدادي بمصر في تعزيز قيم المواطنة الرقمية لدى طلابها واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
•أهمية دور المدرسة بكافة أبعادها سواء أكانت معلمين، أم مناهج دراسية، أم أنشطة تعليمية، أم إدارة مدرسية في تنمية قيم المواطنة الرقمية لدى الطلاب بكافة أبعادها المختلفة،وتوصلت الدراسة لتصور مقترح لتنمية ثقافة المواطنة الرقمية لطلاب التعليم الإعدادي.
الكلمات المفتاحية: المواطنة الرقمية – المدرسة الإعدادية.
Abstract:
The study aimed to identify the role of preparatory education schools in Egypt in promoting the values of digital citizenship among their students. The study used the descriptive approach, and the study reached the following results:
•The importance of the role of the school in all its dimensions, whether teachers, curricula, educational activities, or school administration, in developing the values of digital citizenship among students in all its various dimensions. The study arrived at a proposed vision for developing a culture of digital citizenship for middle school students.
Keywords: Digital Citizenship- preparatory School.
مقدمة:
يواجه العالم العديد من التحديات والمتغيرات ولا سيما المجتمع المصري، ولعل أخطر ما يواجه التكنولوجيا الرقمية وما يصاحبها من تداعيات اقتصادية وثقافية واجتماعية وايديولوجية، ولم يعد العالم كما كان في الماضي، فالحدود الثقافية في طريقها الي التلاشي مما يسمح بأنتقال الثقافة.
ومع ظهور وسائل الإعلام الجديد وشبكات التواصل الاجتماعي المتنوعة والتي سهلت سرعة الحصول على المعلومات ونشرها بين الناس في العالم، كما نتج عن استخدامها ظهور الجماعات الافتراضية التي شكلت إطار جديدا لعلاقات اجتماعية وتفاعل انساني تخطي حاجز الزمان والمكان مما أحدث تأثيرا لا يمكن إغفاله.
مما أفرز تغيرات في أساليب التعبير عن الأفكار ووجهات النظر فضلا عن تغيرات اجتماعية نتج عنها سلوكيات تباينت بين الايجابية والسلبية، فأن أثارها السلبية تبرز مع التمرد على القواعد الاخلاقية والمبادئ الاساسية التي تنظم شئون الحياة الانسانية. فاذا كنا سابقا نستطيع معرفة اهتمام ابنائنا ومراقبة علاقاتهم بالأخرين ساعات يوميا، والآن يتواصلون ويتصلون مع أشخاص مجهولين رقمين قد يشكلون خطرا محتملا وقويا، وقد يدخلون ويتصفحون مواقع مشبوهة خطيرة وأصبح من شبه المستحيل مراقبة كل ما يشاهدونه من صفحات ومواقع ومن يتصلون به من أشخاص مع أنتشار الأجهزة الكفية واللوحية والهواتف الذكية المحمولة في كل مكان وزمان, خصوصا أن الدراسات العلمية أثبتت أن الأطفال والمراهقين يستخدمون هذه الأجهزة تقريبا بمعدل ثماني ساعات يوميا , أي أكثر من الساعات التي يقضونها مع الوالدين والمعلم ,ما يفرض الاستخدام الأمثل والمسؤول للتكنولوجيا وتعزيز المواطنة الرقمية في ظل هذه التحديات الملحة ولذا فقد زادت وتيرة الاهتمام بالمواطنة الرقمية ومفهومها في القرن الحادي والعشرين علي المستويين المحلي والعالمي.
وأقيمت من أجلها العديد من المؤتمرات والندوات لكونها طوق النجاة للدول والمجتمعات من مخاطر الاجتياح الرقمي الذي يموج به العصر الحالي ولأهميتها في حفظ الهوية الرقمية الاصيلة وقواعد السلوك وجوانب العلاقات , وحتي لا تقع الأجيال ضحية لسيطرة رقمية من جهات معادية من دول أخري, وذلك في ظل تدني ثقافة الأستخدام الرشيد لها وقلة الوعي بمهارات التواصل والتعامل الأخلاقي لتلك الشبكات وادراك مخاطرها علي الأجيال, خصوصا عندما يغيب عن الأجيال أن المواطنة في جوهرها التزام عقائدي واخلاقي وحضاري وسلوك يقوم ويشارك به الفرد لصالح تنمية وطنه ومجتمعه والمؤسسة التي يعمل بها.(عصمت ابراهيم العقيل ، 2014, 22) .الأمر الذي يحتم اهتمام المؤسسات التربوية والتعليمية المساهمة بمختلف مستوياتها علي تحقيق المواطنة الرقمية وتعزيزها, وتوعية الأجيال حول قواعد التعامل السوي مع التكنولوجي وكيفية المشاركة بشكل أخلاقي مع البيئة الرقمية وضمان الاستفادة القصوى والمحافظة علي الجانب القيمي والسلوكي لهم في تعاملاتهم الرقمية . (Young donna,2014)
وتظهر أهمية المواطنة الرقمية في أنها تركز على الممارسة الامنة والاستخدام المسؤول القانوي والأخلاقي للمعلومات والتكنولوجيا وفهم القضايا والمشكلات الاجتماعية والثقافية الموجودة في العالم الرقمي وكيفية التعامل معها. (كامل دسوقي الحصري , 2016, 102)
ومن هنا يأتي دور المدرسة وعناصرها التعليمية ومراحلها الدراسية المختلفة وخصوصا المدارس الإعدادية بمصر، كمؤسسة تربوية وتعليمية قادرة على تشكيل الجانب القيمي والسلوكي والأخلاقي والوطني للطالب نحو المواطنة الرقمية الصحيحة والاستخدام الرشيد للتقنية ومن هنا جاءت أهمية هذه الدراسة.
مشكلة الدراسة:
من خلال عمل الباحث في التربية والتعليم , وفي مدارس التعليم الإعدادي خصوصا, لاحظ الباحث أن هناك نسبة كبيرة من اطلاب يمتلكون ويستخدمون الأدوات التكنولوجية والرقمية الحديثة , كما حظ انه بالرغم من الحاجة الضرورية والملحة لوسائل الاتصالات الالكترونية والرقمية وما تقدمه من خدمات رائعة ومفيدة , وما يمكن الحصول عليه من معلومات عن طريقها الا ان هناك بعض السلوكيات السلبية الناتجة عن استخدامها والتي أظهرتها وأكدت عليه بعض الدراسات السابقة مثل دراسة ( الزهراني 2019 ), ودراسة (العتيبي 2018 ) , ودراسة (عباسي وحمدي 2020) و( المسلماني 2014 ) , دراسة ( حشيش 2018 ) ودراسة ( Young Donna 2014 ) . , دراسة ( القارحي 1429ه, 1430) . دراسة (كفافي 2016) ، دراسة (حمد البرثين 2020)، دراسة (الراشد 2019)
في هذا العصر انتشرت التكنولوجيا انتشارا هائلا، وهناك من لا يجيد استخدامها بشكل صحيح ومن أجل ايقاف هذه المشكلة وجد مفهوم المواطنة الرقمية.
لقد أصبحت التقنية جزءا مهما لا يستغني عنها في أمور حياتنا، ومن واجبنا كأفراد ومستخدمين للتقنية أن نسعى ونتعاون لتوظيف التقنية في الطرق الصحيحة وفقا لقواعد أخلاقية سليمة وكيفية المشاركة بشكل أخلاقي مع البيئة الرقية وضمان الاستفادة القصوى والمحافظة على الجانب القيمي والسلوكي لهم في تعاملاتهم الرقمية. (Young Donna , 2014).
ومن يأتي دور المدرسة وعناصرها التعليمية ومراحلها الدراسية المختلفة للتقنية، تربوية وتعليمية قادرة بما تملكه إمكانات وأدوات وأليات واستراتيجيات العمل علي تشكيل الجانب القيمي والسلوكي والأخلاقي والوطني للطالب نحو المواطنة للطالب نحو المواطنة الرقمية الصحيحة والاستخدام الأمثل للتقنية, فضلا عن تزايد معدل استخدام الأطفال والمراهقين لهذه الأجهزة والذي قد يصل الي ثماني ساعات يوميا, تلك الأوقات الطويلة والاستخدام غير الرشيد للتكنولوجيا في ظل تدني وعي طلبة المؤسسات التعليمية بالمواطنة الرقمية يؤدي الي اشكاليات سكوكية خطيرة . (Holland Swarth and et al;2011 :4)
الأمر الذي يؤكد على دور المدرسة لوقاية من تلك المخاطر ومواجهة تلك التحديات من خلال تعزيز ونشر ثقافة المواطنة الرقمية في مدارسنا الإعدادية وبين صفوف طلابنا من برمج ومشاريع وقائية تحفيزية لحماية مجتمعنا من الاثار السلبية للتكنولوجيا وخلق الوعي السليم في التواصل الفعال باستخدام الأدوات الرقمية، ومعرفة القواعد والسلوكيات المرتبطة بالعالم الرقمي والعواقب التي قد يواجهونها إذا تم انتهاك تلك القواعد.
وفي ضوء ما سبق يمكن تحديد مشكلة الدراسة في محاولة الأجابة عن السؤال الرئيس التالي:
- ما التصور المقترح لتنمية وعي طلاب التعليم الإعدادي بثقافة المواطنة الرقمية؟
- ويتفرع عن هذا السؤال مجموعة من الأسئلة الفرعية التالية:
1- ما الإطار المفاهيمي لمفهوم المواطنة الرقمية وعناصرها الأساسية؟
2- ما دور المدرسة في تنمية ثقافة المواطنة الرقمية؟
3- ما دور المناهج الدراسية في المرحلة الإعدادية في تنمية ثقافة المواطنة الرقمية؟
أهداف الدراسة:
1- تعرف مفهوم المواطنة الرقمية وأهمية وعناصره.
2- تعرف دور المدرسة والبيئة التعليمية في تنمية ثقافة المواطنة الرقمية وتعزيزها.
3- وضع تصور مقترح لتنمية وتعزيز المواطنة الرقمية في مرحلة الإعدادي بمصر وزيادة وعيهم بالاستخدام الأمثل للتكنولوجيا في عصر التحول الرقمي.
أهمية الدراسة:
تظهر أهمية الدراسة فيما يلي:
1- تنمية الوعي بثقافة المواطنة الرقمية لدي طلاب التعليم الإعدادي بمصر للارتقاء بمستوي خريجي هذه المدارس في تعاملهم مع التكنولوجيا والمعلومات.
2- القاء الضوء على المواطنة الرقمية وتنميتها لدي طلاب التعليم الإعدادي بمصر بقصد حمايتهم من مخاطر التكنولوجيا وتطبيقاتها.
3- تفيد نتائج الدراسة متخذ القرار ومصممي المناهج الدراسية في تنمية وتعزيز المواطنة الرقمية وكذلك الباحثين والمهتمين في هذا المجال.
4- تقدم الدراسة تصورا مقترحا من خلاله يمكن لمدارس التعليم الإعدادي تنمية وتعزيز المواطنة الرقمية لدي طلابها
منهج الدراسة:
سوف يستخدم الباحث المنهج الوصفي لمناسبته طبيعة الدراسة من حيث جمع وتحليل البيانات المطلوبة للتعرف على دور المدارس الإعدادية في تعزيز المواطنة الرقمية لدي طلابها.
مصطلحات الدراسة:
المواطنة: تمتع أي فرد في المجتمع بالحقوق وامتلاك مجموعة من الامتيازات التي كفلها الدستور مقابل ضرائب ورسوم يدفعها للدولة. (عبد الله السواعير أحمد ،2017)
وأيضا المواطنة: انتماء الفرد للوطن بما يتضمنه ذلك من حقوق الأفراد وواجبات ومسئوليات تقع عليهم تجاه هذا الوطن اي ينتمون اليه..
– وتعرف إجرائيًا: بأنها الشعور بالانتماء، وهي نمط حياة يكتسبه الفرد فطريا ويترسخ بالممارسة الفعلية القائمة على مجموعة من القيم الاخلاقية الايجابية التي يتم أكتسابعا عبر مؤسسات التنشئة الاجتماعية.
المواطنة الرقمية: " مبادئ ومعايير السلوك المسؤول والملائم الخاص بالتكنولوجيا الرقمية Baily & Ribble, 2005: 150))
وتعرف إجرائيًا: بأنها المعايير الفنية والاجتماعية والأخلاقية للاستخدام المسؤول للتكنولوجيا وطريقة الاستخدام الامثل للتنمية الحديثة والمحافظة على القواعد الأخلاقية المنظمة لحياة الانسانية.
والمواطنة الرقمية يعرفها (مروان وليد المصري، وأكرم حسن شعت, 2017) " بأنها القواعد الأخلاقية والضوابط القانونية والمعايير السلوكية والمبادي الوقائية الهادفة لحماية الطلبة من أخطار التكنولوجيا، ليصبحوا مواطنين رقميين قادرين على التكيف والعيش بأمان في العصر الرقمي والتمتع بحقوقهم وتأدية ما عليهم من واجبات ومسئوليات في هذا العصر "
– المواطنة الرقمية: " الانتماء الي مجتمع افتراضي بما يتضمن من حقوق الأفراد وواجبات ومسئوليات، والمشاركة الفاعلة في هذ المجتمع الافتراضي "
وعرفت المواطنة الرقمية بأنها: قواعد التواصل المسؤول والمناسب مع التكنولوجيا ليتمكن الأفراد من الحياة بأمان في العصر الرقمي (Bolkan,2014)
كما عرفت المواطنة الرقمية بانها: " وسيلة لإعداد الطلاب للانخراط الكامل في المجتمع والمشاركة الفاعلة في خدمة مصالح الوطن عموما وفي المجال الرقمي خصوصا (مصطفي القايد ، 2014)
وعرفت أيضا إجرائيًا:" كل ما يمكن أن تسهم به الطلاب للتعامل مع التقنية وحمايتهم من أخطارها، والالتزام بمعايير السلوك المقبول عند أستخدامها لما يحقق المصلحة المجتمعية الصالحة ورفعة الوطن.
الإطار النظري للبحث:
يتألف نظام التعليم العام في مصر من 3 مستويات: مرحلة التعليم الأساسي من سن 4-14 سنة: رياض أطفال لمدة سنين، ثم 6 سنوات مرحلة ابتدائية، وبعد ذلك 3 سنوات مرحلة إعدادية. ويتبع ذلك المرحلة الثانوية لمدة 3 سنوات من سن 15-17 سنة ثم مرحلة التعليم العالي. والتعليم إلزامي لمدة 9 سنوات دراسية ما بين 6 إلى 14 سنة، إضافة إلى ذلك فإن التعليم مجاني في كافة المراحل في المدارس التي تقوم على إدارتها الحكومة، ووفقاً للبنك الدولي هناك فروق كبيرة بين التحصيل الدراسي بين الأغنياء والفقراء وهوما يعرف أيضاً بـ ((فجوة الثروة)). البنك الدولي وعلى الرغم من أن متوسط السنوات التي يتم استكمالها في الدراسة من جانب الفقراء والأغنياء يصل إلى سنة أو سنتين، إلى أن فجوة الثروة تصل إلى 9-10 سنوات. (حسن أبو سعدة،https://award.news)
يعتبر نظام التعليم في مصر شديد المركزية، وينقسم إلى ثلاث مراحل هي:
التعليم الأساس* المرحلة الابتدائية* المرحلة الإعدادية التعليم الثانوي.
التعليم الجامعي منذ دخول قانون التعليم الإلزامي المجاني في عام 1981 ليتضمن المرحلة الإعدادية، فإن كل من المرحلة الابتدائية والإعدادية (في سن 6 حتى 14 سنة) تم دمجها لتكونا مرحلة التعليم الأساسي ويعتمد التعليم في هذه المرحلة على قدرة الطالب.
أولا: التعليم الأساسي في مصر
يتألف التعليم الأساسي من رياض الأطفال، والمرحلة الابتدائية، والمرحلة الإعدادية، وفي مصر تقوم وزارة التربية والتعليم بتنسيق مرحلة رياض الأطفال. وفي المرحلة الابتدائية يمكن الحاق التلاميذ بمدارس خاصة أو دينية أو حكومية
أما الجزء الثاني من التعليم الأساسي فيتمثل في المرحلة الإعدادية أوما قبل الثانوية وهي تمتد إلى 3 سنوات. وباستكمال هذه المرحلة، يحصل الطالب على شهادة إتمام التعليم الأساسي. وتتمثل أهمية استكمال هذه المرحلة في حماية التلميذ من الأمية حيث إن التسرب المبكر من المدارس في هذه المرحلة يؤدي إلى الأمية والفقر في نهاية المطاف. (محمد أحمد حسنين ناصف، 1998، 115-177)
أهداف التعليم الأساسي في مصر: -
أ- توفير الحد الأدنى الضروري من المعلومات والمفاهيم والمهارات والاتجاهات اللازمة للمواطنة والتي سوف يحتاج إليها كل صغير في مجتمعه قبل أن يتحمل مسئولياته الكاملة في مرحلة النضج والرشد.
ب- تزويد التلميذ في فترة التعليم الأساسي بالمهارات العملية القابلة للاستخدام، والتي تمكنه من أن يكون مواطناً منتجاً في مجتمعه، مشاركاً في ميادين التنمية.
ج- تأصيل احترام العمل اليدوي، وممارسته كأساس ضروري لحياة منتجة بسيطة.
د- تنمية شخصية التلميذ، وفكره النقدي البناء، بحيث يتمكن عن وعي، وبالتعاون مع أبناء وطنه، من الإسهام البناء في تنمية مجتمعه، بدءاً من دائرة أسرته إلى دائرة وطنه. (محمد محمد سكران، 2013، 55)
البنية التنظيمية لمرحلة التعليم الأساسي في مصر:
يشير الوضع الحالي لتنظيم مرحلة التعليم الأساسي كالآتي: -
أ- الحلقة الأولى من التعليم الأساسي: هي المدرسة الابتدائية مدة الدراسة بها خمس سنوات وتضم الصفوف من الأول حتى الخامس، وتقسم هذه الحلقة إلى مستويين. (حسين كامل، 1997: 93)
المستوى الأول: يضم الصفوف الثلاثة الأولى ويتم فيه مساعدة الطفل على اكتساب المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب والتربية الدينية.
المستوى الثاني: يضم الصفوف الرابع والخامس ويهدف إلى التأكيد على استخدام الطفل المهارات الأساسية السابقة وتوظيفها في مناشط الحياة اليومية منعاً من الارتداد إلى الأمية.
ب- الحلقة الثانية من التعليم الأساسي:
هي المدرسة الإعدادية مدة الدراسة بها ثلاث سنوات وتضم الصفوف السابع والثامن والتاسع.
ويضم التعليم الإعدادي عدداً من المدارس المختلفة من حيث المناهج، وطبيعة الدراسة، ويضم هذا التعدد ما يلي: - (ابتسام عمر عبد الرازق، 2020، 138-145)
1- المدارس الإعدادية العامة:
تعمل على تزويد التلاميذ بقدر مناسب من المعلومات الثقافية والعلمية التي يمكن استكمالها في المرحلة الثانوية العامة والفنية والتي غالباً ما يلتحق بها المنتهون من التعليم الإعدادي ويقبل بالصف الأول الإعدادي جميع التلاميذ الناجحين في امتحان الصف السادس من الحلقة الأولى (الابتدائية) التي تعقده الإدارة وفق تنسيق تجريه المديريات في الإدارات التعليمية. (حمدي عبد الله عبد العال، 2006: 6045 - 6118)
2- المدارس الإعدادية الخاصة:
منها إعدادي عربي، وإعدادي لغات وهي تتبع نفس الخطة الدراسية التي تتبعها المدارس الإعدادية العامة إلا أن مدارس اللغات تزاد فيها حصص اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى تدريس العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية ويُقبل الناجحون في امتحان الصف السادس الابتدائي بفصول الصف الأول الإعدادي في نفس المدرسة بشرط نجاحهم في امتحان المستوى الرفيع للغة الأجنبية. (طارق الثقفي، 2017: 27)
3- مدارس اللغات التجريبية:
أنشأتها وزارة التربية والتعليم إيماناً منها بأنها سوف تكون منافساً للمدارس الخاصة، وأنها سوف تهتم باللغة الأجنبية خاصة وأننا نعيش عصر المعلومات، وخطتها الدراسية هي نفس خطة مدارس اللغات الخاصة. https://egyptschools.info/
4- المدارس الإعدادية المهنية:
تم إنشاء "المدارس الإعدادية المهنية" بهدف "التغلب على المشكلات التي صادفت المسار الخاص، لأن عدد كبير من التلاميذ لا يقبل بجدية على التعليم الإعدادي، ويتكرر رسوبه فيه، وينتهي به الحال إلى الحصول على ما يسمى بمصدقة التعليم الأساسي، وفي الوقت نفسه لا يستطيع أحد، من هؤلاء الالتحاق بأي مركز من مركز التدريب المهني أو تعليم حرفه في غير هذه المراكز قبل بلوغ سن 16 سنة من عمره، تهتم الدراسة في مدارس التعليم الإعدادي المهني بالتدريبات المهنية حتى يتمكن التلاميذ من الإسهام في مجالات العمل والإنتاج مع تزويدهم بالقدر الضروري من المعلومات الثقافية، يلتحق بها كل من: https://shbabbek.com/show/206762#goog_rewarde
- التلاميذ الذين يبدون رغبتهم في الالتحاق بهذه المدارس بعد اجتياز الحلقة الابتدائية.
- التلاميذ الذين يتكرر رسوبهم بالحلقة الابتدائية بشرط قضائهم أكثر من سبعة أعوام فيها.
- التلاميذ الذين يتكرر رسوبهم مرتين متتاليتين، بالصف الأول أو الثاني الإعدادي.
5- المدارس الإعدادية الرياضية التجريبية:
أنشأت الوزارة بكل محافظة عدد من المدارس الرياضية التجريبية التي تهدف إلى تنمية القدرات الحركية والارتقاء بها، واكتشاف القدرات والمواهب الرياضية لدى التلاميذ، ويقبل بالصف الأول من المدارس الإعدادية الرياضية التجريبية التلاميذ والتلميذات الذين أتموا بنجاح امتحان الصف السادس الابتدائي بشرط اجتياز الكشف الطبي، وتوفير القدرات اللازمة، وحصول التلميذ على بطولة رياضية على المستوى المركزي أو المحلي. https://shbabbek.com/show/237267
6- المدارس الإعدادية للتربية الخاصة:
تتنوع هذه المدارس إلى: مدارس النور للمكفوفين ومدارس الحافظة على البصر، ومدارس وفصول التربية الفكرية، وفصول شلل الأطفال وروماتيزم القلب، ومدارس الأمل للصم وضعاف السمع. https://www.bing.com/search?q
وتسعى الوزارة (ممثلة في الإدارة العامة للتربية الخاصة) بتوفير الخدمات التعليمية لتعليم الفتيات الخاصة تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية وتنفيذاً لنص القانون "التعليم حق لجميع الأطفال المصريين".
إدارة التعليم الأساسي:
البنية التنظيمية للتعليم الأساسي في مصر: -
أ- المستوى الأول: ديوان الوزارة (إدارة مركزية للتعليم الأساسي)
يرأسها وكيل وزارة يتبع مباشرة لوكيل أول الوزارة رئيس قطاع التعليم ويتكون تنظيم الإدارة المركزية للتعليم الأساسي من الإدارة العامة للتعليم الابتدائي، والإدارة العامة للتعليم الإعدادي والإدارة العامة للتربية الخاصة، والإدارة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية.
ب- المستوى الثاني: مديرية التربية والتعليم بالمحافظات
تخضع إدارات المرحلة التعليمية لإشراف وكيل المديرية وتتضمن هذه الإدارات: إدارة التعليم الابتدائي ويرأسها مسئول بمستوى مدير مرحلة، وإدارة للتعليم الإعدادي ويرأسها مسئول بمستوى مدير مرحلة. (كروز تراحيب سالم، 2017، 340)
ج- المستوى الثالث: الإدارة التعليمية بالمركز/ الحي
الإدارة التعليمية من ذات المستوى (أ):
• يتبع مدير عام الإدارة التعليمية مباشرة لوكيل الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.
• إدارات المراحل التعليمية التابعة لإشراف وكيل الإدارة التعليمية يوجد بها إدارة للتعليم الإعدادي وأخرى للتعليم الابتدائي.
• تتم اتصالات إدارات المراحل التعليمية بمستوى المحافظة بالإدارات المماثلة بالإدارات التعليمية (أ) عن طريق مدير عام الإدارة التعليمية المختص.
الإدارة التعليمية ذات المستوى ب، جـ فإن:
• يتبع مدير الإدارة التعليمية لوكيل المديرية بالمحافظة.
• يمارس نشاط التعليم الأساسي عن طريق الأقسام التعليمية التابعة لإشراف وكيل الإدارة التعليمية حيث يوجد قسم للتعليم الابتدائي وقسم آخر للتعليم الإعدادي.
• يشرف رئيس قسم التعليم الابتدائي على عدد من الأقسام التعليمية التي يشرف كل منها على عدد من المدارس الابتدائية الواقعة في نطاق جغرافي معين.
• تتبع الأقسام التعليمية الإشراف الوظيفي لإدارات المراحل التعليمية بالمديرية. (مراد صالح مراد، 1996: 243)
د- المستوى الرابع المدرسة:
تعتبر إدارة المدرسة أصغر وحدة إدارية في النظام التعليمي وإدارة المدرسة الابتدائية تتبع لإدارة/ قسم التعليم الابتدائي بالإدارة التعليمية وإدارة المدرسة الإعدادية تتبع لإدارة/ قسم التعليم الإعدادي بالإدارة التعليمية. وتعمل إدارة كل من المدرسة الابتدائية والمدرسة الإعدادية مستقلة عن الأخرى ويعاون إدارة المدرسة الابتدائية، وإدارة المدرسة الإعدادية مجلسين هما مجلس إدارة المدرسة، ومجلس الآباء والمعلمين.
مصادر التمويل
تمويل التعليم ويتمثل في:
- رسوم غرامات عدم تنفيذ الإلزام من جانب أولياء الأمور.
- حصة رسم تفرض عل طلبات الالتحاق بالمدارس، واستخراج الشهادات، وطلبات التحويل، وغيرها.
- سندات بناء المدارس.
- الإعانات والتبرعات والهيئات من أبناء المجتمع.
وهناك مصدر رابع يتمثل في المساهمات الدولية من هيئات أو دول سواء كانت في صورة منح أو قروض.
- خطة الدراسة والمقررات الدراسية (جيهان محمد مجدي، 2017: 101-121)
مواد الحلقة الأولى (المدرسة الابتدائية) من التعليم الأساسي هي:
التربية الدينية، اللغة العربية، الخط العربي، الرياضيات، والعلوم والدراسات الاجتماعية ، الأنشطة التربوية والمهارات العملية، التربية الرياضية والفنية والموسيقية والمهارات العملية،، اللغة الأجنبية، المكتبة بإجمالي (34 حصة أسبوعياً) للصفوف الأول والثاني والثالث و(38 حصة أسبوعياً) للصفين الرابع والخامس ويلاحظ أن المهارات العلمية تتضمن أربعة مجالات، وهي المجال الزراعي والمجال التجاري والمجال الصناعي، والاقتصاد المنزلي، وتختار كل مدرسة مجالين فقط من بين هذه المجالات، في ضوء ظروف البيئة التي توجد فيها المدرسة، مع مراعاة أن يدرس للبنات مجال الاقتصاد المنزلي بصفة أساسية. (مرهف سليمان، 2022: 11-43)
مواد الحلقة الثانية (المدرسة الإعدادية) من التعليم الأساسي هي:
وتتضمن التدريبات العملية، المجال الزراعي والصناعي، والتجاري والاقتصاد المنزلي، يدرس كل تلميذ مجالاً أساسياً، والمجال الآخر إضافي، على أن تدرس للبنات مجال الاقتصاد المنزلي بصفة أساسية. (محمد السيد، 2017: 588 - 617)
أما بالنسبة لتلاميذ المدرسة الإعدادية المهنية فيدرس التلاميذ المواد الثقافية من الكتب المقررة بالحلقة الثانية من التعليم الأساسي بعد تحديد موضوعات مختارة من هذه الكتب، أما المجالات العملية فلا توجد لها كتب مقررة، وتحدد الوزارة الموضوعات التي يتم تدريسها في كل مجال، وتترك للمدرس حرية التصرف في حدود المنهج المقرر ويخصص 20 حصة للمجالات العملية، ويخصص 20 حصة في الأسبوع للمواد الثقافية. (عماد أمين الحديدي، 2011: (live.com))
وفي المدارس الرياضية التجريبية، يطبق نظام التعليم في المدارس العامة من حيث الخطة، فتسير الدراسة طبقاً للخطة الدراسية المطبقة بالمدارس الإعدادية، على أن يخصص في الجدول المدرسي عدد 10 حصص أسبوعياً للتربية الرياضية وينقسم المنهج إلى جزأين:
• المنهج الخاص بالتربية الرياضية بمدارس التعليم العام
• المنهج الخاص بكل رياضة مدرجة بخطة جماعية وفردية بحيث تشتمل على برامج تدريبية مقننة.
إعداد معلم التعليم الأساسي وتدريبه: متاح على الرابط التالي:
(https://www.bing.com/ck/a?!&&p)
ثانيا: مفهوم العصر الرقمي
عرف “مسلم” (2007: 14) العصر الرقمي على أنه هو الذي يدل على سيطرة الوسائل الرقمية الحديثة على غيرها في مجال الاتصال ومعالجة وتبادل المعلومات، ويتسم هذا العصر بعدة سمات ترجع إلى مزايا الوسائل الرقمية وهي السرعة والدقة وتقريب المسافات وإلغاء الحدود.
وعرفه “مكاوي” (2005) على أنه: العصر الذي يقوم أساسا على نشر المعرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفاءة في جميع مجالات النشاط المجتمعي، ويقصد بأنه “العصر الذي يعتمد في تطويره بصوره أساسيه على المعلومات وشبكات الاتصال والحواسيب.
أى أنه يعتمد على ما يسميه البعض بالتقنية الفكرية تلك التي تضم سلعا وخدمات جديدة مع التزايد المستمر في القوة العاملة المعلوماتية أي تعظيم شأن الفكر والعقل الإنساني بالحواسيب والاتصال والذكاء الاصطناعي.
كما أن العصر الرقمي يعني أن كل أشكال المعلومات يمكن أن تصبح رقمية النصوص، والرسومات والصور الساكنة والمتحركة والصوت، وتلك المعلومات يتم انتقالها وتخزينها وتوزيعها من خلال شبكة المعلومات الدولية بواسطة أجهزة إلكترونية وسيطة الحاسب التقليدي – الهاتف.
ثالثا: خصائص العصر الرقمي
يرى “عبد القادر” (2008: 143-147) أن العصر الرقمي يتميز بعدة خصائص من أهمها:
التطور التكنولوجي الهائل من خلال الثورة الرقمية الأولى، وتتمثل في ظهور الحاسب الآلي الشخصي، والثورة الثانية مثلتها شبكة المعلومات، والثورة الثالثة هي ثورة الوسائط المعلوماتية والمعلومات السريعة.
يعتمد هذا العصر على تحويل أي معلومات أو تعاملات إلى أرقام يسهل نقلها والتعامل معها؛ مما يجعل من الصعب التحكم فيها أو تحديد أو حجب تطورها.
حتمية التغيير حيث إن الثورة الرقمية تختلف عن مثيلاتها من الثورات السابقة، فلها طبيعتها وجوانبها الخاصة.
خلاصة النتائج والتصور المقترح:
أ- ملخص عام لنتائج الدراسة النظرية:
• أهمية دور المدرسة بكافة أبعادها سواء معلمين، أو مناهج دراسية، أو أنشطة تعليمية، أو إدارة مدرسية فى تنمية قيم المواطنة الرقمية لدى الطلاب بكافة أبعادها المختلفة.
- يتألف التعليم الأساسي من رياض الأطفال، والمرحلة الابتدائية، والمرحلة الإعدادية
• لابد للمدرسة من القيام بالدور المنوط بها لخلق جيل على مستوى عالى من الكفاءة العلمية والتعليمية والعمل على خلق أفراد صالحين فى المجتمع يعملون على رقيه ورفعه مستواه على كافة المناحى والأصعدة.
ب-التصور المقترح:
من منطلق أن الهدف الرئيس للدراسة الحالية يتمثل في وضع تصور مقترح يمكن من خلاله تنمية ثقافة المواطنة الرقمية فى مدارس التعليم الإعدادي في مصر، وقد تم بناء هذا التصور في ضوء ما تم عرضه من نتائج الدراسة التحليلية والميدانية، ويتكون التصور المقترح من فلسفة، وأسس، وأهداف، ومتطلبات، وخطوات إجرائية يمكن تبنيها وتطبيقها لتنمية ثقافة المواطنة الرقمية فى مدارس التعليم الإعدادي في مصر وضمانات نجاح تطبيق هذا التصور المقترح، تم تناول ذلك بشيء من التفصيل:
أولاً: فلسفة التصور المقترح:
يعد دور المدرسة وعناصرها التعليمية ومراحلها الدراسية المختلفة كمؤسسة تربوية وتعليمية قادرة بما تملكه من امكانات وأدوات وآليات واستراتيجيات للعمل علي تشكيل الجانب القيمي والسلوكي والأخلاقي والوطني للطالب نحو المواطنة الرقمية الصحيحة والاستخدام الأمثل للتقنية, فضلا عن تزايد معدل استخدام الأطفال والمراهقين لهذه الأجهزة والذي قد يصل إلي ثماني ساعات يوميا, تلك الأوقات الطويلة والاستخدام غير الرشيد للتكنولوجيا في ظل تدني وعي طلبة المؤسسات التعليمية بالمواطنة الرقمية يؤدي إلي اشكاليات سلوكية خطيرة , مما يؤكد علي دور المدرسة للوقاية من تلك المخاطر ومواجهة تلك التحديات من خلال تعزيز ونشر ثقافة المواطنة الرقمية في مدارسنا الإعدادية وبين صفوف طلابنا من خلال البرامج والمشاريع الوقائية التحفيزية لحماية مجتمعنا من الآثار السلبية للتكنولوجيا وخلق الوعي السليم في التواصل الفعال بين الطلاب والمعلمين والإدارة المدرسية .
ثانيًا: رؤية ورسالة التصور المقترح:
(أ) رؤية التصور المقترح:
تفعيل دور مدارس التعليم الإعدادي فى تنمية قيم المواطنة الرقمية ونشر ثقافتها بين الطلاب فى مصر.
(ب) رسالة التصور المقترح:
تركز رسالة التصور المقترح حول وضع وبناء أليات فاعلة تساعد المدرسة بكل مكوناتها من معلمين ومناهج دراسية وأنشطة مدرسية وكذلك إدارة مدرسية لتنمية ثقافة المواطنة الرقمية لدى الطلاب فى مدارس التعليم الإعدادي فى مصر.
ثالثًا: أهمية التصور المقترح:
تكمن أهمية التصور المقترح في النقاط الرئيسة الآتية:
1- العمل على زيادة وعى المعلمين بأهمية تنمية ثقافة المواطنة الرقمية لدى الطلاب لحمايتهم من المخاطر الإلكترونية التى قد يتعرضون لها من خلال عقد الدورات التدريبية للمعلمين وتقديم البرامج التدريبية لهم.
2- العمل على تغيير المناهج بإضافة محتوى تعليمى عن المواطنة الرقمية مما يعزز هذه الثقافة لدى الطلاب ويعمل على تنميتها لديهم.
3- العمل على دعم الأنشطة المدرسية وتنمية دور الأخصائي الاجتماعي وكذلك أخصائي الصحافة والمسرح وتدريبهم لعقد الدورات والندوات وخاصة التى تخص ثقافة المواطنة الرقمية
4- تنمية مهارات مديري المدارس والقيادات التربوية باستخدام وسائل التواصل الحديثة والبرامج والتطبيقات المتطورة لمواكبة التطورات التى تحدث فى المجتمع وتوعيتهم بمخاطرها من خلال عقد الدورات التدريبية وكذلك تبادل الخبرات فيما بينهم
5- تزويد المدراس بشبكات النترنت والعمل على صيانة الأجهزة الموجود فى المدارس واستبدالها فى حالة التلف.
رابعًا: أهداف التصور المقترح:
(أ) أهداف طويلة الأجل:
1- بناء مواطنين صالحين، قادرين على مواكبة التطورات السريعة وتجنب المخاطر التي قد يتعرضون لها.
2- الأرتقاء بالمستوى التعليمى فى مدارس التعليم الإعدادي فى مصر.
3- التقليل من الأثار السلبية لاستخدام الطلاب الإنترنت والتعامل مع التكنولوجيا
4- مساعدة متخذي القرار ومصممي المناهج الدراسية في تنمية وتعزيز المواطنة الرقمية
5- مواكبة الأتجاهات التربوية الحديثة لاعداد الطلاب لمواجهة متغيرات العصر الرقمي.
(ب) الأهداف العامة:
1- القضاء على الأمية الرقمية فى مصر سواء على مستوى الطلاب أو المعلمين
2- تشجيع الطلاب على الإقبال على المدرسة.
3- رفع مستوى مدارس التعليم الإعدادي، وتغيير النظرة السيئة لها مقارنة بالتعليم العام
4- التأكيد على دور المعلم كموجه ومرشد ومربى فاضل فى العملية التعليمية.
5- رفع مستوى الخدمات التعليمية المقدمة فى مدارس التعليم الإعدادي فى مصر.
6- العمل على توفيرالأجهزة وشبكات الأنترنت فى المدارس.
7- تطوير أداءات المدرسة في ضوء التطورات المتلاحقة التي يشهدها العصر.
8- تحقيق نواتج تعليمية فعالة تلائم متطلبات القرن الحادي والعشرين.
9- تطوير مصادر التعلم الإلكترونية الجذابة للمتعلمين فى العملية التعليمية لتحقيق تعلم أفضل.
10- تدريب والمعلمين، والأخصائيين، والإداريين، والقيادات المدرسية على استخدام التكنولوجيا الحديثة.
11- تطوير مستوى الرعاية للطلاب من خلال عقد الندوات واللقاءات وتوعية أولياء الأمور بمخاطر التكنولوجيا.
خامسًا: منطلقات التصورالمقترح:
اعتمد الباحث في إعداد التصور المقترح على الإطار النظري ونتائج الدراسة النظرية، للتعرف على أهم جوانب القوة والضعف فى تنمية ثقافة المواطنة الرقمية لدى الطلاب فى مدارس التعليم الإعدادي فى مصر.
(أ) إجراءات مرتبطة بدورالمعلمين
يعد المعلم محور ارتكاز العملية التعليمية فهو المرشد والمدرب والميسر للطلاب وهو الذي يعمل على تزويدهم بمختلف المعارف والقيم والخبرات، وبذلك فهو القدوة والمثل الذي يحتذى به، وبالتالي فإن له دوراً هاماً فى عملية التحول الرقمى وتحقيق المواطنة الرقمية، لكونه مرجعاً مهنياً وتربوياً فى الجانب التقني والإلكتروني والمعلوماتي. فضلاً عن دوره فى ترسيخ مفهوم الانتماء الوطني، وما يقوم به من توظيف للتكنولوجيا بطرق جديدة لتحفيز الطلاب على التعلم، وذلك من خلال استخدامه لوسائل واستراتيجيات عصرية فى تدريس الطلاب تمكنه من تنمية شخصيتهم وتثقيفهم بالمعلومات والأفكار والقيم الإيجابية، ولذلك تتبنى الدراسة الحالية بعض الإجراءات وهي:
1- تدريب المعلمين فى مدارس التعليم الثانوى الفنى على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة.
2- عقد لقاءات اسبوعية بين المعلمين بمواعيد محددة وثابتة لمناقشة ما مروا به من خبرات مع طلابهم أومن خلال استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الأنترنت.
3- تخصيص دورات تدريبية للاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين للتدريبهم على كيفية التعامل مع إدمان الأنترنت لدى الطلاب وكيفية التغلب على هذه المشكلة وتجنبها قبل حدوثها.
4- تزويد المعلم بالقدرة على انتاج الوسائط المتعددة التي تساعده على تفعيل التعلم., ممايساعد فى تفعيل دور المعلم لنشر ثقافة المواطنة الرقمية لدى الطلاب فى مدارس التعليم الإعدادي.
5- يجب على المعلمين استعمال أدوات التكنولوجيا ومصادر التعليم لزيادة الإنتاجية ودعم الابتكار وتسهيل التعلم الأكاديمي.
6- يجب على المعلمين تنمية قدرة الطلاب على تحديد الاستخدام المناسب وغير المناسب للتكنولوجيا، وذلك وفقاً للقواعد والقوانين الاخلاقية لهذا الاستخدام.
7- تنمية روح القدرة على تحمل المسؤلية تجاه الأمن الإلكترونى والفكرى والحيطة والحذر من الجرائم المعلوماتية بتنمية ذاته فكرياً وسلوكياً ونقداً لدى الطلاب.
8- اشراك الطلاب في حوار حول أستخدام التكنولوجيا لشراء السلع والخدمات
(ب) إجراءت مرتبطة بدور المناهج الدراسية
تعتبر المناهج وأساليب التعلم أداة هامة لتحقيق التواصل الفكري والتماسك الاجتماعي فى المجتمعات، وتعمل على بناء أفراد صالحين فى المجتمع إذا ما تم تطبيقها بشكل صحيح، لذلك فهناك مجموعة من الإجراءات التي يجب اتباعها ومنها:
1- وضع مناهج منفصلة خاصة بالمواطنة الرقمية يتم تدريسها للطلاب كمواد دراسية لها معلمين متخصصين لتدريسها
2- اظهار الخبرات المعززة للتكنولوجيا، تلك التي تنصب على معايير المحتوي ومعايير التكنولوجيا للطلاب.
3- لابد للمناهج أن تعمل على تنمية قدرة الطلاب على إنتاج المعرفة والتحول من ثقافة النقل إلى ثقافة العقل.
4- تدريس مخاطر سرقة الهوية وكيفية حماية الطلاب أنفسهم من التعرض لهذه المخاطر الإلكترونية
5- انشاء مناهج تدريس محو الأمية الإلكترونية والمواطنة الرقمية.
(ت) إجراءات مرتبطة بدور الأنشطة المدرسية
تقوم الأنشطة بدور بالغ الأهمية فى تنمية قدرات الطلاب، حيث إنها تعمل على اشراك الطلاب كأعضاء فاعلين وأفراد منتجين فى المجتمع، كما انها تساعد فى تنمية قدرة الطلاب على الشعور بالمسؤولية تجاه المحيطين والمجتمع، لذلك فلابد من اتباع مجموعة من الإجراءات لتفعيل دور الأنشطة ومنها ما يلي:
1- إتاحة الفرصة للطلاب لممارسة بعض الأنشطة التي تدعم المواطنة الرقمية
2- إدارة أنشطة تعلم الطلاب في البيئات المعززة للتكنولوجيا
3- إفراد جزء من اليوم الدراسى للمارسة الأنشطة سواء كانت صحافة أو إذاعة كأنشطة يومية، وكذلك توفير وقت مناسب لعقد الندوات واللقاءات مع اولياء الأمور، وكذلك مع الأفراد من المجتمع المدني.
4- العمل على توظيف التقنيات في الأنشطة المختلفة
(ث) إجراءات مرتبطة بدور الإدارة المدرسية:
تعتبر المدرسة أداة مهمة لتحقيق التواصل الفكري والتماسك الاجتماعي فى المجتمع، ومقرراتها الدراسية التي يدرسها الطلاب تعمل على تدعيم وترسيخ هذا الأمر، لذلك فلابد من توافر بعض الجراءات التى يجب أن تقوم بها المدرسة لتنمية ثقافة المواطنة الرقمية لدى طلابها ومن هذه الإجراءات ما يلي:
1- توفير الوسائل التكنولوجية اللازمة في المدرسة
2- صنع قرارات واعية حول التكنولوجيا في دعم تعلم الطلاب نتيجة لتقييم الممارسات المهنية.
3- تنمية وعى القيادات المدرسية بأهمية ثقافة المواطنة الرقمية على الأفراد والمجتمع.
4- اهتمام المدرسة متمثلة فى إدارتها بتشجيع الطلاب والمعلمين على ممارسة السلوكيات الصحيحة للمواطنة الرقمية.
5- المحافظة على الانضباط فى المدرسة لتحسين جودة وكفاءة العملية التعليمية.
6- الاهتمام بتنفيذ الأنشطة الطلابية وعقد الندوات للطلاب وأولياء الأمور حول المواطنة الرقمية.
7- توفير الدعم اللازم سواء كان مادياً أم بشرياً للوصول إلى أقصى نتائج ممكنة من تنفيذ الأنشطة.
8- توفير الدعم الكافى من قبل القيادات فى وزارة التعليم الفنى لدعم تنمية ثقافة المواطنة الرقمية.
سادسًا: آليات تنفيذ التصور المقترح
(أ) موافقة وزارة التربية والتعليم الفني على تطبيق التصور المقترح وتوجيه الهيئات التدريبية ذات العلاقة لتسهيل تنفيذ التصور المقترح.
(ب) توفير الإمكانات والمصادر اللازمة من شبكات أنترنت وأجهزة كمبيوتر فى مدارس التعليم الإعدادي.
(ج) توفير الدعم المادي والبشري اللازم لتنفيذ التصور المقترح.
(د) توفير مناهج دراسية خاصة بالمواطنة الرقمية أو على الأقل تخصيص وحدات دراسية فى بعض المواد لتدريس ثقافة المواطنة الرقمية
سابعًا: معوقات تطبيق التصور المقترح:
1-العجز الشديد فى أعداد المعلمين فى المدارس مما يجعل المعلمين غير قادرين على تأدية المهام الأساسية، مما يدفعهم إلى ضرورة التركيز على المناهج الدراسية وعدم الإهتمام بالجوانب الأخرى
2-اقتصار اليوم الدراسى على الحصص الدراسية وعدم وجود وقت كافي لممارسة الأنشطة التعليمية.
3- عدم كفاية البرامج التدريبية المقدمة للمعلمين فيما يخص المواطنة الرقمية.
4- عدم توافر الإمكانات المادية من أجهزة وشبكات أنترنت.
5- رفض بعض المعلمين والقيادات التربوية لفكرة التغيير ورفض كل ما هو جديد فى العملية التعليمة، وكذلك ضعف خبراتهم بالتكنولوجيا الحديثة.
ثامنًا: حلول مقترحة للتغلب على معوقات تطبيق التصور المقترح:
1- توفير ميزانية خاصة لتوفير الأجهزة وشبكات الأنترنت اللازمة للمدارس.
2- تنمية الوعي بأهمية المواطنة الرقمية وذلك من خلال عقد الندوات والمؤتمرات واللقاءات الشعبية مع أولياء الأمور لزيادة الوعي بالمواطنة الرقمية بين أفراد المجتمع بشكل عام.
3- تحفيز المعلمين على استخدام وسائل التعلم والتقويم الإلكترونية وتقديم جوائز تشجيعية للمعلمين المهتمين بالمواطنة الرقمية.
4-عقد دورات وندوات للمعلمين بشكل دورى لنشر ثقافة المواطنة الرقمية.
مـراجـع الـدراسـة
أولا: مراجع عربية:
ثانيا: المراجع الأجنبية:
مـراجـع الـدراسـة
أولا: مراجع عربية:
ثانيا: المراجع الأجنبية: